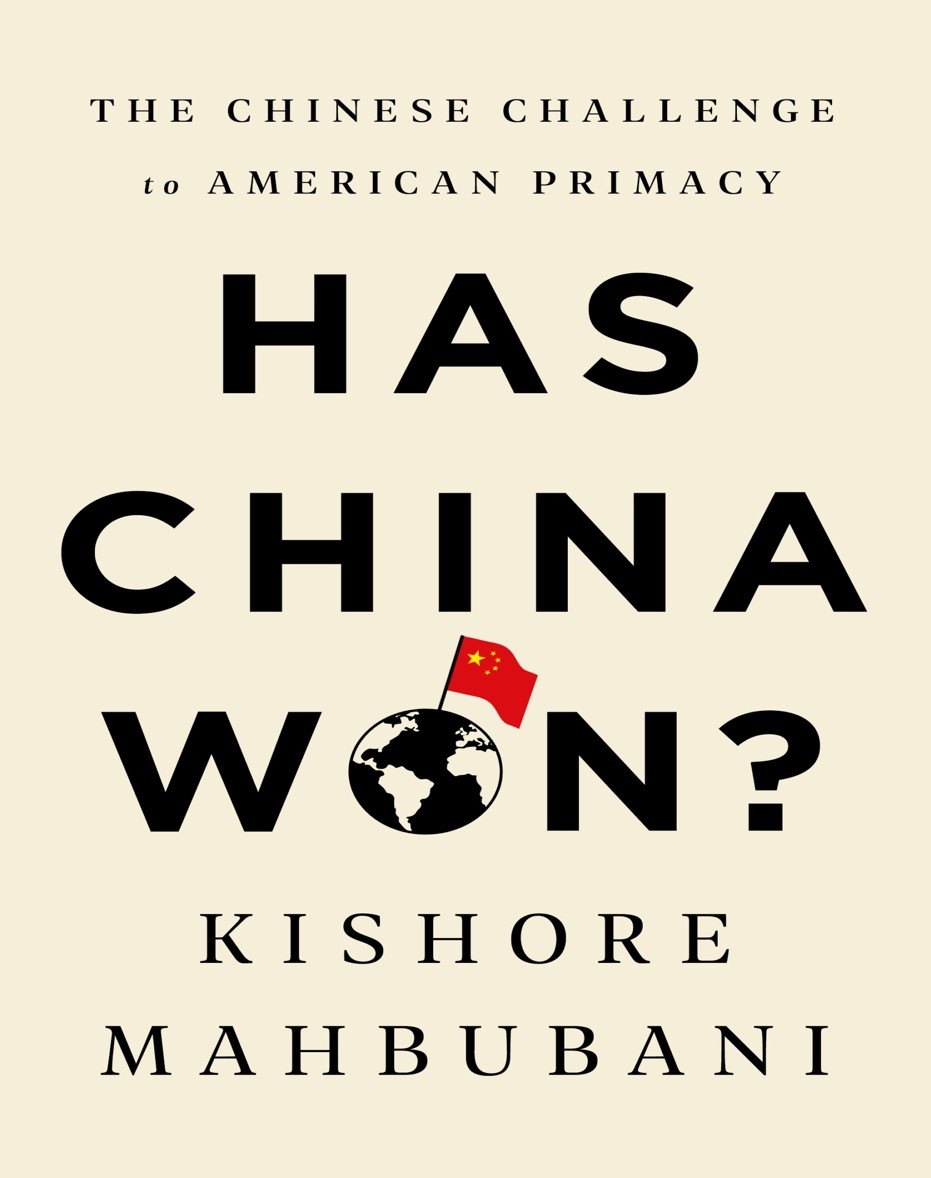هل ربحت الصين؟ التحدي الصيني للصدارة الامريكية
تأليف: كيشور محبوباني
عرض ومراجعة: جلال خَشِّيبْ
محتويات المراجعة:
مقدّمّة
- صُورٌ مغلوطة
- تاريخٌ عريقٌ مُسالم
- لن تُحاكي الصين أمثلة التوسعيّين
- كيف نُفسّر الإجراءات الدفاعية الصينية المعاصرة؟
- هل ستشهدُ العقود المُقبلة حربًا ما بين الصين وجيرانها؟ قضية تايوان وتوتّرات بحر الصين الجنوبي
خاتمة
في كتابه هل فازت الصين؟ التحدّي الصيني للصدارة الأمريكية، يُقدّم كيشور محبوباني رؤيةً غير غربيةٍ عن مسألة الصعود الصيني، تتميّزُ بسرديةٍ مختلفةٍ حدّ التناقض عن السردية التّي تُهيمن على الكتابات الغربية بخصوص هذا الموضوع. يُخصّصُ الكاتب الفصل الرابع من الكتاب لمناقشة أحد أكثر الأسئلة تداولاً بين الباحثين الانجلوساكسون: هل سيكون صعود الصين صعودًا سلميًا؟ إجابةً عن هذا السؤال، يكاد يُجمع باحثيِ العلاقات الدولية الأمريكيين (لاسيما منهم الواقعيين والليبراليين) وكذا صنّاع القرار داخل الأبيت الأبيض ومؤسّسة الخارجية والكونغرس الأمريكي بأنّ صعود الصين لن يكون صعودًا سلميًا أبدًا، مُقدِّمين في هذا الصدد حُججًا عديدةً يختلطُ فيها الذاتي بالموضوعي والمصالح الشخصية بالمصالح العليا للبلاد. يطرح محبوباني في هذا الفصل ذات السؤال بصيغةٍ أخرى: “هل تُعدُّ الصين قوّةً توسعيّة؟” ليُقدّم -إجابةً عنه- حُججًا متنوّعةً تنفي كون الصين قوّةً توسعيّةً وتُفنّدُ كثيرًا ممّا يصفه بكذب الباحثين وصنّاع القرار الأمريكيّين أو سوء قراءاتهم للصين وتاريخها ونواياها وسلوكاتها الخارجية في جوارها الإقليمي والعالم.
يقع هذا الفصل في 23 صفحة ضمن كتابٍ ذي حجمٍ متوسّط مكوّنٍ من 236 صفحة صادرٍ باللغة الإنجليزية عن دار الشؤون العامّة للنشر– نيويورك في شهر أبريل 2020.
الكلمات المفتاحيّة: الصين، الصعود السلمي، قوّةٌ توسعيّة، حُججٌ تاريخية، الصدارة الأمريكية
صُورٌ مغلوطة:
في بداية الفصل، يُقدّم الكاتب تفسيره للأسباب التّي تقف وراء رواج صورةٍ مغلوطةٍ عن الصين في العالم الغربي خصوصًا، مُرجِعًا ذلك إلى عامليْن أساسيين. أولاًّ، ما يُسمّيه بالأكاذيب التّي تُرَوّج منذ عقودٍ في العالم الانجلوساكسوني على نطاقٍ واسعٍ حول الصين، والتّي تُولِّدُها بيئةٌ فريدةٌ تنخرط فيها أفضل أجهزة الاستخبارات والصحف عبر العالم، حيث تتقاسم خمسةُ دولٍ أساسيةٍ من العالم الانجلوساكسوني (وهي أمريكا وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدّة) فيما بينها وبثقةٍ كبيرةٍ معلوماتٍ استخباراتيةٍ عن الصين، كما تتشاركُها من وقتٍ لآخر مع صحفٍ غربيةٍ رائدة، لكنّها لا تُقدّمُ لها صورةً كلّيةً عن الحقيقة، على غرار حقيقة تكثيف الجيش الصيني سنة 2015 لأنشطته في جزر سبراتلي التّي عرض عدم عسكرتها، لكنّ “الحقيقة المفقودة”” غير المُبَلَّغِ عنها تتمثّلُ في إثارة البحرية الأمريكية عبر دوريّاتها الاستفزازية هناك ردّ فعلٍ عسكريٍ من طرف الجيش الصيني ليُضيّع أوباما آنذاك فرصةَ توافقٍ صيني-أمريكي بخصوص الوضع المتوتّر في تلك الجزر.
أمّا العامل الثاني فراجعٌ في نظره إلى الجمود الذّي يتصّف به النظام السياسي الصيني تاريخيًا، فلم تكن الصين تاريخيًا بارعةً في شرح وجهات نظرها أو الدفاع عنها، ومن الصعب العثور على متحدّثٍ رسميٍ جيّد يُمكنه -بروح الدعابة والرؤى الحادّة واللغة الانجليزية- شرح المنظور الصيني بشكلٍ فعّال.
تاريخٌ عريقٌ مُسالم:
يتناول الكاتب بعد ذلك في هذا الفصل بشكلٍ مُفصّلٍ جملةَ الحجج التّي تُمكّن الصين من إثبات أنّها ليست قوّةً عسكريةً توسعيّةً بطبيعتها كما يدّعي هؤلاء. يُقدّم التاريخ الصيني أبرز حجّةٍ في هذا السياق، فلو كانت الحضارة الصينية حضارةً عسكريةً بطبيعتها لظهرت علاماتٌ عن ذلك منذ زمن بعيد. فعلى مدى الألفي عام الماضية، كانت الصين أقوى حضارةٍ منفردةٍ في الكتلة الأوراسية، لكنّها لم تغزو مناطقًا في الخارج كما فعلت القوى الأوروبية في الماضي. خضعت أستراليا، على سبيل المثال، للاحتلال من قِبل القوّات البريطانية البعيدة، لا من طرف الصين القريبة منها جغرافيًا بالرغم من أنّ الصين كانت ذات قوّةٍ بحريّةٍ ضخمةٍ منذ القرن 15م، أيْ حتّى قبل أن يشرع الأوروبيّون في احتلال العالم منذ القرن 16م، حيث بلغت اكتشافاتها الجغرافية القارّة الافريقية.
يُحاجج الكاتب أيضًا بأنّ الصينيّين كانوا يكرهون إرسال قوّاتٍ عسكريةٍ بعيدًا، فضلاً أنّ شعب الهان الصيني شعبٌ زراعيٌّ في الأساس، انتشروا عبر أراضي الصين أين وجدوا التربة الزراعية المناسبة، وكانت التضاريس الوعرة حدودًا لهذا الانتشار.
أمّا التوسّع الاقليمي الصيني عبر التاريخ في مناطق كمنغوليا الداخلية أو شينجيانغ فقد كان تحت حكم سلالاتٍ أجنبيةٍ حكمت الصين، ولم يتسبّب فيه شعب الهان الصيني المُسالم، كسلالة (Yuan: 1279-1368) أو سلالة (Qing: 1644-1911). أمّا إقليم التبت فقصّته أكثر تعقيدًا. تعرّض الاقليم للغزو من قِبل الصين حينما كانت الأخيرة تحت حكم المغول عام 1244، ثمّ تمتّع “باستقلاليةٍ كبيرة” في ظلّ حكم سلالة يوان، بعدها في القرون التالية للغزو الأوّلي نشبت صراعاتٌ حول مسألة السيطرة على التبت من قِبل الحكومات الصينية المختلفة إلى أن تمّ دمج الاقليم رسميًا في جمهورية الصين الشعبية سنة 1950.
باختصار، على مدار الألفيْ عام الماضية لم يكن الصينيين الهان عسكريّين أو توسّعيّين، رغم قوتّهم البحريّة أو الديمغرافية، تكفي مقارنتهم بجيرانهم المغول مثلاً الذّين غزو آسيا قديمًا وهدّدوا أوروبا بالغزو. لم يُحاكي الصينيّون مِثال المغول ولم يتأثرّو بثقافتهم العسكرية رغم الاختلاط الثقافي الكبير بين العرقين، بل حدث العكس تمامًا، حيث تأثّر المغول بالفلسفة الكونفوشيوسية الهادئة الصبورة.
لن تُحاكي الصين أمثلة التوسعيّين:
يُقدّم الكاتب هذه المقارنات التاريخية حتّى يُفنّد ححج الباحثين الأمريكيين الذّين يدّعون بأنّ الصين سوف تتجّه لمحاكاة الولايات المتحدّة في سلوكها التوسّعي العالمي منذ نهاية القرن 19م، بعدما هيمنة على جوارها الإقليمي. حينما تصبح الصين أكثر قوّة، فإنّها -ككلّ القوى العظمى- ستُؤكّد قوتّها ونفوذها حسبما يرى محبوباني، ومثلما كان على جيران الولايات المتحدّة في أمريكا اللاتينية أن يتكيّفوا مع القوّة الأمريكية منذ نهاية القرن 19م، سيتعيّن على جيران الصين أيضًا التكيّف مع قوّة الصين. إلاّ أنّ الصين لن تلجأ إلى الوسائل العسكرية كأول تعبيرٍ عن قوتّها. أولاًّ، لأنّ تاريخها المُمتّد على مدى ألفيْ عام يُثبتُ بوضوحٍ بأنّها تختلف اختلافًا جوهريًا عن أمريكا، فهي مُتريّثةٌ دومًا في استخدام الخيار العسكري، فلم تَخض الصين منذ 40 سنةً حربًا كبرى، كما لم تُطلق رصاصةً عبر حدودها منذ 30 سنة، وهذا ما يعكس دوافع حضاريةٍ عميقةٍ لديها، هنا يُسجّل الكاتب حيرةَ الصينيّين من تورّط أمريكا في حروبٍ غير ضروريةٍ في مناطق لا تخدم مصالحهم الحيويّة كليبيا وسوريا، ويرى بأنّ الصينيّين تعلّموا في هذا الزمن من أمريكا درسًا حكيمًا، وهو الامتناع عن التورّط في معارك غير ضرورية، بعدما رأوا حماقة الاسراف في التدخّلات العسكرية الأمريكية. ثانيا، لأنّها لا تعتقد بأنّ لديها “مهمّةً عالمية” (مثل أمريكا) لترويج الثقافة الصينية وتشجيع البشرية على تقليدها مثلما يفعل الأمريكيون، حيث يعتقد الصينيّون العكس تمامًا، بأن لا أحد غيرهم قادرٌ على أن يكون صينيًا في الثقافة والقيم والجماليات.
كيف نُفسّر الإجراءات الدفاعية الصينية المعاصرة؟
في قسمٍ آخر من هذا الفصل، يشرح الكاتب السلوكات الدفاعية الصينية في جوارها الاقليمي والتّي يتخّذ منها الأمريكيون ذريعةً لتبرير الصورة العدوانية التّي يروّجونها عن الصين وتجعلهم يُجمعون اليوم (رسميًا) بأنّ الصين تُمثّل تهديدًا لنمط الحياة الأمريكية والأمن القومي الأمريكي.
يُجادل محبوباني بأنّ السلوك الدفاعي الصيني (في شكل تأمينٍ للحدود الوطنية وسيادتها) يُعدُّ تأكيدًا للسيادة العسكرية الصينية المعاصرة، مُرجِعًا الذهنية الدفاعية الراسخة للصين المعاصرة إلى الذاكرة التاريخية الاستراتيجية للصين، حيث كان الأمن القومي الصيني مُهدَّدًا منذ القرون الأولى من قِبل دول الجوار (المغول، المنشوريين، اليابانيين.. ثمّ بعدهم جاء تهديد القوى الامبريالية الغربية). تعلّم الصينيون من التاريخ أيضًا بأنّ الاجراءات الدفاعية المحضة لم تكن ناجحةً على الدوام، فقد فشل سور الصين العظيم في الحيلولة دون الغزو الأجنبي قديمًا، لهذا السبب يمزجُ الفكر الاستراتيجي الصيني المعاصر بين مقارباتٍ عسكرية وسياسية وتجارية واقتصادية مختلفة في التعامل مع دول الجوار (مثلا استخدام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة، مبادرة الحزام والطريق، منظمة شنغهاي للتعاون..). هكذا، فإنّ ما يصفه المفكرّون الأمريكيون بالنزعة التوسعيّة الصينية يُمكن تفسيره بشكلٍ أدّق من خلال هوس الصين –المُسترشِد بتاريخها الطويل والمُؤلِم من الاذلال والغزو- بتأمين حدودها من خلال “توطيد علاقاتها مع الدول المجاورة لها”.
هل ستشهدُ العقود المُقبلة حربًا ما بين الصين وجيرانها؟ قضية تايوان وتوتّرات بحر الصين الجنوبي:
يستبعدُ الكاتب هذا الاحتمال نظرًا لأنّ جميع جيران الصين المحاذِين عاشوا بجوارها منذ آلاف السنين فطوّروا غرائز دقيقةٍ حول كيفية إدارة العلاقات مع صينٍ صاعدة، كما أنّ للنخبة الصينية (خلافًا للنخبة الأمريكية) فهمًا عميقًا لتاريخها الطويل مع الجيران.
إلاّ أنّ محبوباني يستثني تايوان من ذلك، مُعتبرًا إيّاها السبب الاستثنائي الوحيد لحربٍ يُمكن أن تنخرط فيها الصين، إنّها القضية الوحيدة التّي لا يستطيع الصينيّون فيها الانحناء والتنازل رغم ما يتميّز به قادتهم السياسيّون من مرونةٍ سياسيةٍ كبيرة.
يرجع السبب الرئيسي لذلك إلى ما يُعرَف لدى الصينيّين “بقرن الإذلال” الذّي عانت منه الصين منذ حرب الأفيون الأولى ما بين سنة 1839 إلى سنة 1949. لقد أزالت الصين بعدها كلّ البقايا التاريخية لهذا القرن، بما في ذلك قضيّة هونغ كونغ وماكاو، وبقيت قضيةٌ واحدةٌ فقط وهي تايوان، فكلّها كانت أراضي صينية إلى أن اضطرت الصين إلى تسليمها لليابان بعد الهزيمة المُذِلّة في الحرب الصينية-اليابانية (1894-1895). أُصيبت الصين بعدها بخيبات أملٍ متكرّرةٍ من القوى الغربية بعد وعودٍ كاذبةٍ عديدةٍ بأنّها ستُعيد لها تايوان إذا ما تعاونت الصين مع قوى الغرب في مناطق مع العالم كأوروبا ضدّ ألمانيا. لذلك، يتسبّب أيّ تحرّكٍ أمريكيٍ أو غربيٍ اليوم لدعم انفصال تايوان عن الصين -بشكلٍ مباشر أو غير مباشر- في استرجاع هذه الذاكرة التاريخية وإثارة ردّ فعلٍ قوميٍ قويٍّ وصارمٍ من شأنه أن يُعيق أيّ زعيمٍ صينيٍ قد يُحاول البحث عن مجالٍ ما للمناورة.
يُنوّه محبوباني إلى أنّه من الخطأ أن يدّعي أيُّ أمريكيٍّ بأنّ مزاعم بيجين بشأن تايوان دليلٌ على أنّها دولةٌ توسعيّةٌ عدوانيةٌ مادامت كلٌّ من تايوان والصين مُتفّقتان بأنّهما تنتميان لبلدٍ واحد. كما يشير أيضًا إلى تعمّد بعض الإدارات الأمريكية، لاسيما إدارة ترامب، استفزاز الصين خطابًا وسلوكًا لاثارة غضبها ودفعها للقيام بفعلٍ عسكريٍ عبر مضيق تايوان، لأنّ الأمريكيّين يدركون بأنّ أيّ زعيمٍ صينيٍ مُعرّضٌ للخطر من الناحية السياسية إذا نظر إليه شعبه أو نخب الحزب الحاكم الصيني كزعيمٍ ضعيفٍ فيما يتعلّق بتايوان، لذا وحمايةً لمركزه السياسي، قد لا يكون أمامه سوى خيار اتّخاذ إجراءٍ عسكريٍ ما.
يُسجِّل الكاتب وجود نوعيْن من القيود التّي تحول دون غزو الصين لتايوان من جانبٍ واحدٍ ومن دون استفزاز وهي: أولاًّ، التعهّد الأمريكي القانوني بضمان أمن تايوان بشكلٍ مطلقٍ وبكلِّ الوسائل. ثانيًا، وجود مصلحةٍ وطنيةٍ صينيةٍ في استمرار المُختبَر الاجتماعي والسياسي الذّي يفرضه وضع تايوان والذّي يُساعدها على معرفة كيفية عمل المجتمع الصيني تحت حكم نظامٍ سياسيٍ مختلف، حيث يُمكِنُ للصين أن تتعلّم دروسًا بعيدة المدى من تايوان حول كيفية تعامل الصينيّين مع الديمقراطية، كما أنّ من مصلحة أمريكا على المدى البعيد أن يكون لديها مجتمعٌ ديمقراطيٌ يعمل بشكلٍ جيّد في تايوان. هكذا يرى الكاتب بأنّ هناك تقاربٌ في المصالح بين الصين والولايات المتحدّة فيما يتعلّق بتايوان.
يحثّ محبوباني الولايات المتحدّة على تغيير نظرتها لتايوان إذا أرادت أن تصل إلى اتفّاقٍ قريبٍ مع الصين بخصوصها وأن تبدأ قبل كلّ شيئٍ بتغيير الاستعارات التّي تستخدمها في وصف هذا البلد، حيث يصفه الأمريكيون عادةً بحاملة طائراتٍ أمريكيةٍ غير قابلةٍ للغرق متمركزة في خاصرة الخصم الصيني (حينما يريدون التصعيد مع الصين)، بينما يُفضّلُ الكاتب وصفها بكونها “فيروسًا صحيًّا” بامكانه أن يُحفّز الجسم السياسي للمجتمع الصيني (وهكذا يصفها الأمريكيون حينما يريدون التهدئة معها).
إلى جانب تايوان، فقد ولّدت قضايا بحر الصين الجنوبي توتّراتٍ عسكريةٍ وتصادمًا محتملاً بين البحريّة الأمريكية والصينية هناك. فالطريقة التّي تقوم بها البحريّة الأمريكية في تسيير دوريّاتها هناك على بُعد 12 ميلاً من شواطئ الصين طريقةٌ مستفزّة. للعلم، لا تقوم السفن الصينية بدورياتٍ بحريّةٍ على بُعد 12 ميلاً من شواطئ كاليفورنيا أو نيويورك الأمريكية. تدّعي أمريكا بأنّها تقوم بذلك حمايةً للصالح العالمي العام، أيْ “حريّة الملاحة في أعالي البحار”. للمفارقة فإنّ الصين هي أكبر مستفيدٍ من هذا الادّعاء، فهي تُتاجر مع بقيّة دول العالم أكثر ممّا تقوم به أمريكا وليس من مصلحتها أبدًا إعاقة هذه الحريّة كما يتّهمها الأمريكيون. يذكر الكاتب هنا بأنّ الصين لا تُسيطر إلاّ على مجموعةٍ قليلةٍ من الصخور والشعاب المتنازع عليها ضمن مجموعة جزر سبراتلي والباراسيل في بحر الصين الجنوبي مقارنةً بكلٍ من فيتنام والفلبين وماليزيا، مع ذلك لا يتّم الحديث سوى عن “عسكرة الصين لهذه المياه وتهديد الجيران”.
أخيرًا، يطرح محبوباني مجموعةً من الأسئلة بخصوص مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية وطبيعة التنافس بينهما وما هي أفضل الطرق لحلّ الاختلافات في وجهات النظر بينهما فيما يتعلّق بقضايا بحر الصين الجنوبي وغيرها، داعيًا إلى ضرورة اغتنام واشنطن للفرص التّي تقدّمها الصين لتهدئة الوضع في بحر الصين الجنوبي أو تايوان بدلاً من التعامل بعجرفةٍ واستفزازٍ تجاهها بوسائل عسكرية، مُختتمًا هذا الفصل بقوله: “إذا لم تكن المنافسة الحقيقية بين أمريكا والصين في المجال العسكري (مستقبلاً)، فهل من الحكمة أن تُركّز أمريكا على تعزيز قدراتها العسكرية (في جوار الصين) في الوقت الذّي تكون فيه المنافسة الحقيقية في المجال غير العسكري؟ هل حان الوقت إذن لتُغيّر واشنطن إجماعها الاستراتيجي بشأن الصين؟”
نُشر المقال لأول مرّة بمجلّة جُسور الجيوبولتيك (GPB)، الصادرة عن مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA)، المُجلّد الأول، العدد الأول، شتاء 2023.

كيشور محبوباني، باحث رئيس بمعهد آسيا للأبحاث-الجامعة الوطنية لسنغافورة. عمل ضمن السلك الدبلوماسي السنغافوري لمدة 33 عامًا (1971-2004)، حيث شغل مرّتين منصب سفير سنغافورة لدى الأمم المتحدة والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية ما بين عام 1993 – 1998. كما شغل منصب العميد المؤسّس لكلية “لي كوان يو” للسياسة العامة ما بين 2004-2017. لـ محبوباني أكثر من سبعة كتب منشورة، منها: “هل يمكن أن يفكر الآسيويون؟” (2018)، “هل يمكن لسنغافورة البقاء؟” (2021) وغيرهما. تشمل اهتماماته البحثية مجالات: الجيوبولتيك العالمية والحوكمة العالمية، عودة انتعاش آسيا ورابطة آسيان، والسياسات العامّة في سنغافورة.
الموقع الإلكتروني الخاصّ بالباحث:

جلال خَشِّيبْ، باحث رئيس بمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) التابع لجامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بتركيا. تهتّم أعماله البحثية بمجال الجيوبوليتيك، نظريات العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى، جيوبولتيك أوراسيا وبحر الصين الجنوبي وشمال إفريقيا، السياسة الخارجية التركية والسياسة الخارجية الجزائرية. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات والملخصّات الأكاديمية المنشورة بالعربية والإنجليزية، من مؤلّفاته كتاب: “النظام الدولي الليبرالي: جون ميرشايمر في مواجهة جون آيكينبري-صعودٌ أم سقوط؟” (2021)، وكتاب: “أثر التحوّلات الطارئة في بنية النظام الدولي على التوجّهات الكبرى للسياسة الخارجية التركية” (2017)، وكتاب: “آفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا” (2015).
الصفحة الخاصّة بالباحث في موقع أصوات نقدية- مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية CIGA: