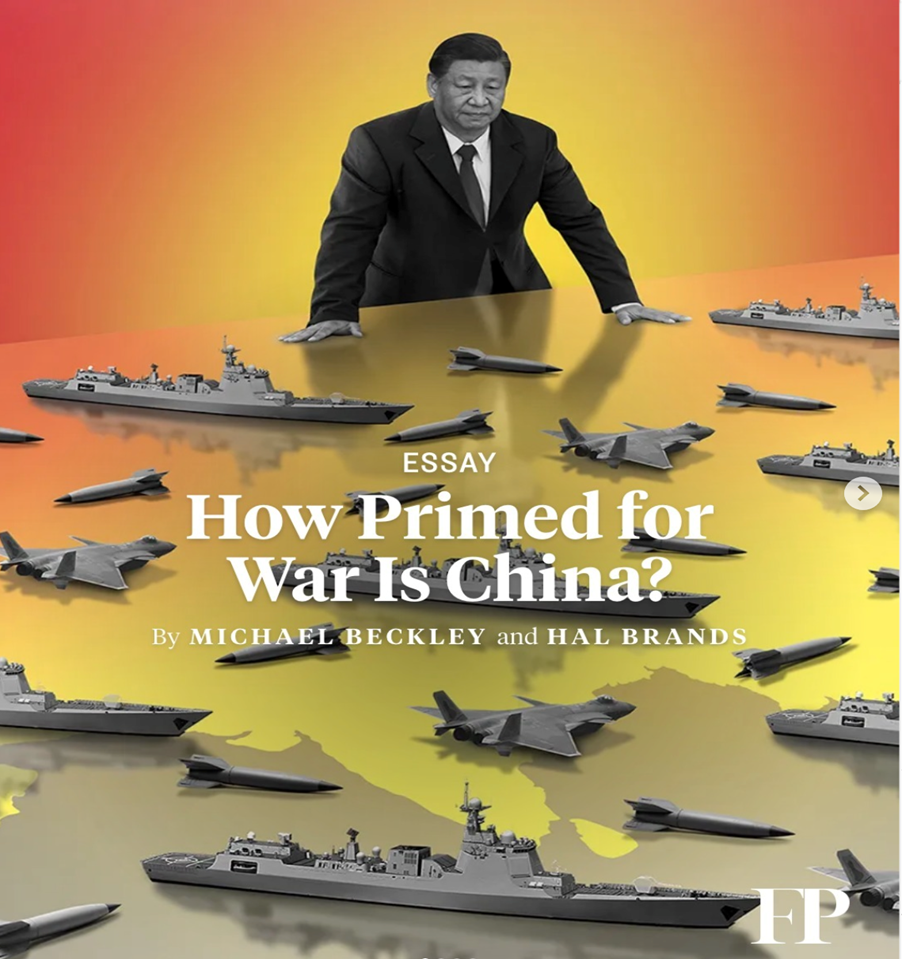الكلمات المفتاحيّة: معضلة تايوان، شي جينبينغ، احتمالية الحرب، ذروة القوة الصينية، التنافس الصيني-الأمريكي
Hal Brands and Michael Beckley, How Primed for War Is China? Foreign Policy, February 4, 2024/ USA
في هذا المقال، يُجادل كلٌّ من هال براندز ومايكل بيكلي بأنّ احتمالية بدء الصين لحربٍ ضدّ تايوان أو ضدّ هدفٍ آخر في منطقة الباسفيك الغربي أصبحت مرتفعةً للغاية مقارنةً بما كان عليه الأمر في الماضي. وقد يؤدّي إقدام الصين على ذلك إلى نشوب صراعٍ مع الولايات المتحدة من المحتمل أن يتصاعد إلى حربٍ بين قوتين نوويتين تتنافسان من أجل الهيمنة على هذه المنطقة وخارجها. وفي خِضّم النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، يمكن أن يتسبّب هذا السيناريو في إغراق العالم في صراعاتٍ مترابطةٍ عبر مناطق رئيسيةٍ من القارة الأوراسية تُذكِّرُ بحجم الصراع الذّي شهده العالم خلال الحرب العالمية الثانية. ينبّه المقال إلى أنّ علامات التحذير من عدوان الصين المحتمل باتت واضحة، وذلك بالرغم من الجهود الدبلوماسية الأخيرة المبذولة بين بجين وواشنطن. وبينما يعتقد بعض المحلّلين أنّ خطر العدوان الصيني مبالغٌ فيه ويمكن إدارته بوسائل دبلوماسيةٍ حذرة، يُجادل براندز وبيكلي بأنّ التغيّرات الطارئة في ظروف الصين قد تؤدّي إلى موقفٍ أكثر عدوانية منها، حيث تُسهم عواملٌ مثل النزاعات الإقليمية، وتحوّلات التوازن العسكري، والآفاق الاقتصادية المُظلِمَة للصين، وأسلوب قيادة شي الاستبدادي في زيادة خطر النزاع. وعلى الرغم من أنّ موعد حدوث النزاع يكتنفه اللايقين، إلاّ أنّ المؤشّرات تشير إلى أنّ خطر العدوان الصيني كبيرٍ ويستحق الاهتمام.
“دِيجَا فُو”: لا يقين الصعود السلمي للصين:
يفترض الكاتبان أنّ سلوك الصين قد يخضع لتغييراتٍ بناءً على التطوّرات الداخلية والظروف الخارجية. على الرغم من أنّ احتمالية نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين قد تبدو بعيدةً، حيث لم تخضَ بجين حربًا كبرى منذ 44 عامًا، إلاّ أنّ السلوكيات العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والصراعات مع جيرانها كالهند تؤشّر إلى وجود إمكانيةٍ للتصعيد. يُطرح من قبل المسؤولين الصينيين الصعود السلمي لبلدهم، مقارنةً بتاريخ أمريكا المليء بالحروب، ومع ذلك تُحذّر السوابق التاريخية من هذه الحجّة، إذْ عرف التاريخ قوى عديدة بدأ صعودها يبدو سلميًا ليتحوّل لاحقًا إلى صعودٍ عدواني. على سبيل المثال، قبل الحرب العالمية الأولى، ظلّت ألمانيا نسبيًا قوة صاعدةً سلمية لأكثر من 40 عامًا. في العشرينيات من القرن الماضي، بدت اليابان كلاعبٍ مسؤول، حيث وقّعت معاهداتٍ لتقييد قوتّها البحرية والتعاون في آسيا. بالمثل، في أوائل الألفية الجديدة، تطلّعت روسيا لعلاقاتٍ أقرب مع حلف شمال الأطلسي والغرب تحت قيادة فلاديمير بوتين. مع ذلك، وعلى الرغم من هذه النيّات السلمية التّي أبدتها هذه القوى، فقد انخرطت جميعًا في نهاية المطاف في حروبِ غزوٍ عدوانية. تُسلّط هذه المسألة الضوء على عدم إمكانية التنبؤ بسلوك الدول، مُظهرةً أنّ الظروف المحيطة قد تؤدّي إلى إحداث تغيراتٍ جذريةٍ في سلوكيات الدول مع مرور الوقت. وفي حين أنّ الحرب بين الولايات المتحدة والصين قد تبدو غير محتملة، يُحذّر التاريخ من إغفال هذه الإمكانية تمامًا.
عواملٌ مُحفّزة على العدوان:
يسلّط القسم الثاني من المقال الضوء على العوامل التّي قد تدفع الصين إلى شنّ حربٍ محتملة. تشمل هذه العوامل؛ النزاعات الإقليمية، والتحوّلات الجارية في القوة العسكرية، والخوف من الانحدار المستقبلي، وطبيعة النظام السياسي الصيني. «إنّ حوالي 85٪ من النزاعات الدولية التّي تمّ شنّها منذ سنة 1945 دارت حول مطالبٍ تتعلّق بالأرض». تعرف النزاعات حول الأراضي، المُنقادة بالأهمية الرمزية والاستراتيجية التّي تمثّلها الأرض المتنازع حولها، في كثيرٍ من الأحيان تصعيدًا عندما يخشى أحدُ أطرافِ النزاع فقدان السيطرة. إضافةً لذلك، فإنّ التحولات الجارية في التوازن العسكري تُعتبر سببًا آخر للحرب. تنشأ الحروب من التفاؤل الزائف عندما يعتقد كلا الطرفين أنّ بإمكانهما الفوز، خاصّةً عندما يصبح التوازن العسكري أكثر تنافسيةً أو غموضًا، يحدث ذلك مثلاً حينما يقوم الطرف الأضعف بإدخال تقنياتٍ جديدةٍ أو إقامة تعزيزٍ عسكريٍ ضخم يزيده قوة. علاوةً على ذلك، قد تتحوّل القوى العظمى إلى قوى عدوانية عندما تشعر بتباطؤ اقتصادي أو تُحاصَر استراتيجيًا على نحوٍ يُهدّد موقفها ومكانتها الدولية. قد تنزلق حتّى أقوى الدول إلى حالةٍ من عدم الاستقرار العنيف عندما تُواجِه تباطؤًا اقتصاديًا، أو عزلةً استراتيجية، أو تحدّياتٍ ثابتةٍ مستمرةٍ تُعرّض مكانتها العالمية للخطر وتجعلها عرضةً للاعتداء من قِبل الخصوم. أخيرًا، فإنّ الديكتاتوريات، الميّالة إلى التطرّف والمحاطة بالموالين، تُعتبر أكثر ميلاً لبدء الحروب لأنّها أقلّ تعرّضًا لتكاليف الصراع. تُسلّط هذه العوامل الأربعة الضوء على احتمالية مَيْل الصين للعدوان اليوم.
نزعةٌ عدوانية كامنة: صعودٌ مستمر وسط صراعات:
في القسم الثالث يفحص الباحثان مسألة “التاريخ السلمي/العدواني” للصين منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية سنة 1949. يُجادل الباحثان أنّ الصين وُلِدت في خِضّم الصراع وتحمّلت قرنًا من الاستعمار الأجنبي تلاه التدمير الذّي تعرّضت له بسبب الحرب العالمية الثانية والحرب الأهلية الدموية لاحقًا. نشأت الصين وسط هذه الصراعات كدولةٍ فائقةِ العدائية، حيث شاركت في خمس حروبٍ وأصبحت عدّوًا رئيسيًا للقوتين العظمتين في الحرب الباردة. تحت حكم الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، الذّي تميّز بالسلطة الدكتاتورية وعدم الاكتراث بحياة الإنسان، وفق تعبير الكاتبين، صارت الصين شديدة العدائية ومخرطةً في حروبٍ متعدّدة. على سبيل المثال، أثار ماو أزمةً دوليةً سنة 1958 من خلال قصف الجزر التّي تسيطر عليها الحكومة الوطنية في تايوان. هكذا وجدت الصين نفسها محاطةً بجيران معادين أو غير مستقرّين على طول معظم حدودها. بحلول عقد الستينيات، كانت حدود الصين مع الاتحاد السوفيتي معسكرةً بشكلٍ كبير. كانت تايوان، بدعم من الولايات المتحدة، تهدف إلى استعادة الصين الرئيسية، أمّا الهند فقد استضافت حكومة التبت في المنفى وادّعت بأنّ لها حقوقًا في أجزاءٍ من الأراضي الصينية. بالإضافة إلى ذلك، كان قلب الصين متموضعًا بين نقاط توتّرِ الحرب الباردة، بين الهند-الصينية وشبه الجزيرة الكورية. عزّزت هذه الحدود الخطيرة الشعور بالضعف المستمر والانكشاف، وزادت من حدّة النزاعات الإقليمية.
من خمسينيات القرن العشرين إلى ثمانيناته، بادرت الصين لشنّ عدّة نزاعات، مدفوعةً بمخاوف الانحدار، حيث يُقدّم الكتابان العديد من الأمثلة في هذا الصدد. مع ذلك وبعد وفاة ماو، عاشت الصين تغيّراتٍ كبيرة. باشرت قيادة دينغ شياوبينغ إصلاحاتٍ مؤسّسية وتحوّلات جيوبوليتكية، ممّا أدى إلى تقليص حجم التهديدات المفروضة على سلامة الأراضي الصينية. خلال السبعينيات، مع انفتاح الولايات المتحدة على الصين، تحسنّت العلاقات القائمة بين القوتين وخفّف نمو الاقتصاد من عدوانية الصين. أيضًا، لاحتواء الاتحاد السوفيتي، أقامت الولايات المتحدة شبه تحالفٍ مع الصين، حيث تشاركت تكنولوجيا متقدّمة مع شركاتٍ صينية. تسبّبت هذه الشراكة في ردع تايوان، والاتحاد السوفيتي، والهند، وفيتنام عن تهديد الأراضي الصينية بسبب أخطار التدخّل الأمريكي ضدّ هؤلاء لصالح الصين. مع انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991، تلاشت التهديدات الرئيسية على الحدود البريّة الصينية تقريبًا تمامًا. كلّ هذه العوامل أدّت إلى فترةٍ نسبيةٍ من السلام بالنسبة للصين ودفعتها إلى التركيز على التنمية الاقتصادية والاندماج في المجتمع العالمي.
ملامحُ عدوانٍ صيني في الأفق:
يعتقد الكاتبان، في القسم الرابع من المقال، أنّ الصين قد تخلّت عن غطاء السريّة والصبر، وهي الآن تزيد بوضوحٍ من قدراتها العسكرية بمعدّلٍ غير مسبوق. يتّم إنتاج السفن الحربية والصواريخ بكمياتٍ كبيرة، مع إجراءِ عملياتِ مُحاكاةٍ لهجماتٍ عدوانيةٍ تستهدف تايوان ومصالح الولايات المتحدة. تَتخلّل مواقعٌ عسكرية صينية الممرّات البحرية الآسيوية، بينما تتجمّع القوات على طول الحدود الصينية الهندية. وينبع هذا الموقف القتالي للصين من قدرةٍ مكتشَفةً حديثًا، حيث ازدادت ميزانية الصين العسكرية بمقدار عشرة أضعاف منذ العام 1990، والآن تتجاوز هذه الميزانية الإنفاق العسكري لجميع الدول الآسيوية مجتمعةً. تفخر الصين بحيازتها لأكبر بحريةٍ في العالم وأكبر قوة صواريخ باليستية، بإمكانها منافسة ترسانة الولايات المتحدة النووية بنهاية العقد الحالي. ومع تواجد قاعدة أوكيناوا العسكرية الأمريكية ضمن نطاقِ مرمى الصواريخ الصينية، فإنّ الاستجابة الفورية للولايات المتحدة ضدّ هجومٍ صيني على تايوان تبقى غير مؤكّدة. ومع قدراتِ التصنيع الضخمة الحالية للصين «ربما تعتقد بجين -سواء بشكلٍ صحيح أو غير صحيح- أنّ التوازن العسكري سيتحوّل إلى مصلحتها بشكلٍ أكبر كلّما استمرت الحرب لفترةٍ أطول». هناك العديد من العلامات التّي تثبت أنّ الصين لديها دوافعٌ متزايدة للحرب. النزاعات الإقليمية تغذّي عدوان الصين، كما أنّ الخيارات السلمية لإعادة توحيد تايوان تتضاءل مع تحوّل مشاعر التايوانيين نحو الاستقلال، المدعومين بعلاقاتٍ قويّةٍ مع الولايات المتحدة. في بحر الصين الجنوبي، تتزايد القوة العسكرية للصين، إلاّ أنّ نفوذها الدبلوماسي يتراجع. كما تعمل الدول المُقاوِمة للصين، كالفلبين واليابان، على تقوية تحالفاتها الدفاعية مع الدول الغربية، متحديةً سلوكيات بجين العدوانية. علاوةً على ذلك، يجادل الكتابان بأنّه ومع زيادة قوة جيش الصين، فإنّ اقتصادها يعرف تراجعًا، إضافةً لارتفاع معدّلات البطالة والديون، وأزمة تقدّم السنّ لدى السكان هناك. في الوقت نفسه، تُقيّد البيئة العالمية المُعادية وصول الصين إلى التكنولوجيا الحيوية وتُعزّز التحالفات المعادية لها. على سبيل المثال، فإنّ الائتلافات المعارضة للصين، مثل “أوكوس” و”كواد” و”الاتفاقية ثلاثية الأطراف” بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، تكتسب زخمًا متزايدًا. علاوةً على ذلك، فقد انخرطت الصين مع روسيا بشكلٍ كبير في أوكرانيا، ممّا تسبّب في ردود فعلٍ سلبية ضدّ بجين لدى الرأي العام الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ موقف الصين اللامبالي تجاه المطالب المتعلـّقة بالأراضي وطموحاتها كقوة عظمى لهو أمرٌ يثير القلق. إنّ تماسك سلطة شي واستعداده للصراع، بالإضافة إلى العنف الداخلي كانتهاكات نظامه لحقوق الإنسان، تشير جميعًا إلى وجود إمكانية واستعداد لشنّ عدوانٍ خارجي. «في السنوات الأخيرة، ألقى شي خطابات داخليةً تُوجِّه تعليماتٍ للجيش الصيني بالاستعداد للحرب وحثّ الشعب الصيني على التحضير لـ “سيناريوهات متطرفة”». هذه العوامل تؤكّد ضرورة التحلّي بالحذر فيما يتعلّق بسلوكيات الصين المستقبلية على الساحة العالمية.
الكاتبان لا يثقان في التصوّرات التّي ترى أنّ سلوكيات روسيا في أوكرانيا قد تثني الصين عن المخاطرة بمغامراتٍ عدوانية في جوارها، والتّي تُعتبر درسًا تحذيريًا بخصوص أخطار العدوان العسكري. يرى براندز وبيكلي أنّ الدروس الحقيقية المُستفادة لا تعكسها البيانات العامّة لمسؤولي الدولة، بل من المحتمل أن تكون متأثّرةً بتصوّرات شي جينبينغ، “الزعيم الشمولي للصين”، على حدّ تعبيرهما. تشير التصريحات العامّة لشي جينبينغ إلى التزامٍ منه بقيادة تغييراتٍ عالميةٍ كبيرةٍ إلى جانب روسيا، ممّا يُوحي بموقفٍ صينيٍ لا يتزعزع، فعندما زار شي موسكو في مارس 2023، قال لبوتين: «الآن، هناك تغييرات -تُشابهُ تلك التّي لم نشهدها منذ مئة عام- ونحن الذّين نقود هذه التغييرات معًا”. علاوةً على ذلك، قد لا تتماشى آراء شي حول الصراع الدائر في أوكرانيا مع توقعات الغرب، فعلى عكس وضع روسيا، تستعّد الصين منذ فترةٍ طويلة لصراعٍ محتملٍ بشأن تايوان وتحافظ على رؤيةٍ استراتيجيةٍ متميّزة. قد ينظر شي إلى استجابات الغرب لأزمة أوكرانيا على أنّها غير فعّالة، الأمر الذّي من شأنه أن يعزّز ثقته في قدرة الصين على تحمّل الضغط الدولي وتحقيق أهدافها.
هل سيُشعل التوتّر عبر مضيق تايوان حربًا قادمة مع الصين؟ وما الذّي ينبغي لواشنطن فعله؟
في القسم الأخير من المقال، يناقش براندز وبيكلي حدود إمكانية حدوث عدوانٍ عسكريٍ صيني ضدّ تايوان أو ضدّ دولٍ أخرى. لا يزال الأمر غير يقيني، وفقًا لهما، لاسيما مع وجود عوامل متغيّرة تؤثّر على احتمالية مثل هذه السلوكيات وتوقيتها. ارتكازًا على الفهم التاريخي لأسباب الحرب فإنّ الصين تميل حاليًا نحو ممارسة العنف. في الوقت نفسه، تُواجِه القوى الخارجية، كالولايات المتحدة، قيودًا في تغيير هذه الديناميات. وبينما لا يمكن لواشنطن إيجاد حلٍّ لتحدّيات الصين الديموغرافية أو الاقتصادية مباشرةً، فإنّ بإمكانها التأثير على تصوّر بجين للنتائج المستقبلية الناجمة عن سلوكياتها، ممّا قد يردع العدوان. للحدّ من تفاؤل الصين بنتيجة الصراع، هناك حاجةٌ إلى تبنّي إجراءاتٍ استراتيجية، بما في ذلك تقوية القدرات الدفاعية التايوانية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الباسفيك الغربي. يدعو الكاتبان إلى تعزيز التحالفات وتشكيل تحالفٍ عالميٍ لفرض عقوباتٍ اقتصادية، فهما أمران أساسيان أيضًا. ومع ذلك، تتعثّر الجهود المبذولة لمواجهة التهديد العسكري الصيني بسبب نقص الضرورة الاستعجالية والموارد. في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة تحقيق توازنٍ بين الردع والتطمين، خاصّةً فيما يتعلّق بتايوان، وذلك لمنع حدوث تغييراتٍ أحاديةِ الجانب للوضع القائم. يُعتبر تجنّب الأفعال الاستفزازية، مثل الدعم العلني لاستقلال تايوان، أمرًا أساسيًا لإدارة التوتّرات، كما أنّ الحفاظ على التزامٍ دفاعيٍ موثوق تجاه تايوان مع التمسّك بسياسةِ الصين الواحدة لهو أمرٌ بالغُ الأهمية في التعامل مع هذه التعقيدات.
يختتم براندز وبيكلي مقالهما بالتأكيد على أنّ هذه الاستراتيجية مليئةٌ بالتناقضات، حيث يمكن أن يزيد تعزيز الردع من تخوّفات الصين، ممّا يُعقّد الدبلوماسية العابرة للمضيق. ويجب التعامل بحكمة مع الضرورة المُلحّة لمعالجة سَيْر الصين نحو العدوان، خاصةً وسط الاعتبارات السياسية الداخلية. ومع توجّه الصين نحو الصراع، سيتطلّب الأمر حلولاً ثابتةً ورشاقةً دبلوماسية من طرف الولايات المتحدة وحلفائها لتفادي نتائج كارثية.

أستاذ فخري للشؤون العالمية في مدرسة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدّمة، وباحث أول بمعهد المشروع الأمريكي، وبمركز التقييم الاستراتيجي وتقييم الميزانية. كما أنّه كاتب عمود في منصّة بلومبورغ. يُعتبر براندز أحد أبرز صقور النزعة الأُممية الليبرالية، حيث اشتغل كمساعدٍ خاصّ لوزير الدفاع للتخطيط الاستراتيجي ما بين 2015-2016، وهو زميل باحث في مجلس العلاقات الخارجية للشؤون الدولية، كما اشتغل كمستشار لدى العديد من المكاتب الحكومية ووكالات مجتمع الاستخبارات والأمن القومي. يتميّز براندز بغزارة انتاجه المعرفي فهو كاتب ومُحرّر للعديد من الكتب، منها: “الاستراتيجية الأمريكية الكبرى في حقبة ترامب” (2018)، “صُنع لحظة الأحادية القطبية: السياسة الخارجية الأمريكية وصعود نظام ما بعد الحرب الباردة” (2016)، “دروس المأساة: فنّ الحكم والنظام العالمي” (2019). آخر كتبه المنشورة كتاب “منطقة الخطر: الصراع القادم مع الصين”، بالاشتراك مع مايكل بيكلي (2022).

أستاذٌ مشاركٌ بكليّة علم السياسة في جامعة تافت الأمريكية. يشتغلُ كباحث أول غير مقيم بمعهد المشروع الأمريكي ومدير برنامج آسيا بمعهد بحوث السياسة الخارجية، وكان باحثًا أول متخصّصًا في الأمن الدولي بمدرسة كينيدي للحوكمة في جامعة هارفرد. يُعتبر بيكلي خبيرًا في العلاقات الأمريكية-الصينية وقد اشتغل لدى وزارة الدفاع الأمريكية ومؤسّستيْ راند وكارنيجي للسلام الدولي، كما يواصل تقديم المشورة لمكاتبٍ عديدة داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية. من مؤلّفاته كتاب «منقطعة النظير: لماذا ستبقى أمريكا القوة العظمى الوحيدة في العالم» (2018)، وكتاب «المنطقة الخطرة: النزاع القادم مع الصين»، بالاشتراك مع هال براندز، (2022).

باحث رئيسي بمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) التابع لجامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بتركيا. تهتّم أعماله البحثية بمجال الجيوبوليتيك، نظريات العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى والنظام الدولي، جيوبولتيك أوراسيا وبحر الصين الجنوبي وشمال إفريقيا، السياسة الخارجية التركية والسياسة الخارجية الجزائرية. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات والملخصّات الأكاديمية المنشورة بالعربية والإنجليزية، من مؤلّفاته كتاب: “النظام الدولي الليبرالي: جون ميرشايمر في مواجهة جون آيكينبري-صعودٌ أم سقوط؟” (2021)، وكتاب: “أثر التحوّلات الطارئة في بنية النظام الدولي على التوجّهات الكبرى للسياسة الخارجية التركية” (2017)، وكتاب: “آفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا” (2015).