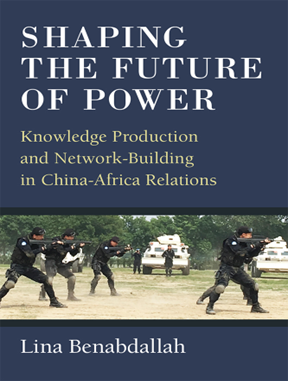Lina Benabdallah, Shaping the Future of Power: Knowledge Production and Network-Building in China-Africa Relations (US: University of Michigan Press, July 2020)
مقدّمة
I. بناء شبكة الارتباطات في العلاقات الصينية-الإفريقية بين الماضي والحاضر
II. النظرية الارتباطية، رأس المال الاجتماعي ومستقبل القوة
III. “غوانشي” في الدبلوماسية العسكرية والبرامج التدريبية الأمنية
خاتمة واستنتاجات: القوة الارتباطية ما وراء العلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا
مقدّمة:
عرفت السنوات الأخيرة تزايدًا هائلاً في عدد الكتب والدراسات ذات الصلّة بالصين، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث تُعتبر الصين الموضوع الأول والأكثر أهميّة اليوم بالنسبة لأغلب باحثي العلاقات الدولية الأمريكيّين، فضلاً عن وجود إجماعٍ نسبي بين السياسيّين وصنّاع القرار هناك بخصوص أولوية الاهتمام بكلّ ما له علاقة بالصين الصاعدة وسياستها الإقليمية والعالمية نظرًا لما تُمثّله من تحدّي لمركز الصدارة الأمريكية العالمية.
وبسبب هيمنة المقاربات التقليدية لنظريات العلاقات الدولية (من بين أسبابٍ أخرى) على رؤية كثيرٍ من الباحثين لموضوع السياسة الخارجية الصينية وانتشارها العالمي، عادةً ما ينصّب إهتمام هؤلاء على تحليل المظاهر الماديّة للقوة الصينية وتواجد مظاهرها الملموسة عبر العالم، كالاهتمام مثلاً بمشاريعها الاقتصادية على غرار مشروع القرن المُسمى بـ “مبادرة الحزام والطريق BRI“، والاستثمار في البنية التحتيّة للدول التّي يمر عبرها هذا الطريق في شقّيْه البرّي والبحري، من موانئٍ وطرقٍ سريعةٍ وسككٍ ومباني رسمية وملاعبٍ ومُرفَقات. إلاّ أنّ الاهتمام بالمظاهر المجرّدة غير الماديّة لملامح القوة الصينية والانتشار الصيني عبر دول العالم لم يحظى بتركيزٍ مماثلٍ من طرف الباحثين. هنا تظهر أهميّة كتاب “تشكيل مستقبل القوة” للباحثة لينا بن عبد الله، أستاذة السياسة والشؤون الدولية بجامعة وايك فوريست الأمريكية، والمتخصّصة في الشؤون الصينية وأحد المنشغلين على مشروع نظريات العلاقات الدولية والجنوب العالمي. الكتاب من الحجم المتوسّط (191 صفحة)، صدر سنة 2020 عن منشورات جامعة ميشيغان الأمريكية. تهتّم بن عبد الله بمتابعة الملامح المجرّدة غير الماديّة في سياسة الصين الخارجية، مُركّزةً الاهتمام على إبراز هذه الملامح في علاقات الصين بدول القارّة الافريقية فيما تُعبِّر عنه الكاتبة بمظاهر الاستثمار في “إنتاج المعرفة” و”بناء شبكة العلاقات” عبر برامج الاستثمار في تنمية موارد رأس المال البشري والاجتماعي في دول القارّة السمراء.
يشير رأس المال الاجتماعي وشبكة العلاقات الاجتماعية هنا إلى شبكة العلاقات الشخصية والمهنية وكذا شبكة العلاقات الاجتماعية، إنّها العامل الذّي يُمَكّن الفواعل من أن تصير قويّة. كما تهتّم الكاتبة -من بين أمورٍ عديدة- بتتبّع آثار تعزيز ونشر المعرفة الفنيّة/التقنية والمعايير/القيم وطرق التفكير بخصوص الحَوْكَمَة والتنمية والأمن التّي تمارسها الصين في دول القارّة بناءً على خبرتها وتجربتها، وتُحاجج بأنّ الصين تصير مع الزمن قوةً أساسيةً في هذا الصدد، وبأنّ إدراك هذا البُعد من شأنه أن يساعدنا على فهم طريقة تشكيل الصين لمستقبل القوة، فشبكة العلاقات الاجتماعية والعلاقات المتمركزة على أساس الأفراد تُعتبر عاملاً مركزيًا في الممارسة “الناجحة” للسياسة الخارجية الصينية، “حتّى في المناطق التّي قد تتوقّع فيها نظريات العلاقات الدولية التقليدية نزعةً ماديّةً للهيمنة” وفقا لتعبير الكاتبة. وبالتالي فإنّ الاهتمام بدراسة وفهم النسيج الاجتماعي وشبكة العلاقات الاجتماعية المبنيّة من طرف الصين هناك (حتّى وإن لم تكن مرئيةً بالشكل الكافي) يجب أن يحظى بنفس أهمية ووزن الاهتمام بدراسة التحديد الجغرافي للاستثمارات الصينية في الموانئ المتواجدة بإفريقيا أو إحصاء عدد الملاعب والطرق السريعة التّي تمّ بناؤها من طرف الشركات الصينية مثلا.
هكذا فإنّ الكتاب يستخدم إطارًا نظريًا مختلفًا عن المقاربات التقليدية المهيمنة في حقل العلاقات الدولية من أجل تحليل وشرح آثار إنتاج المعرفة ونقل المهارات وهذه الأبعاد غير الماديّة في السياسة الخارجية الصينية. تستعين الكاتبة بمقاربة ميشال فوكو الشهيرة عن علاقة السلطة/القوة بالمعرفة، وكيف تُنتج السلطة/القوة المعرفة (والعكس)، وذلك في سعيها لفهم علاقات السلطة/القوة والمعرفة في الجنوب العالمي وبالتحديد في علاقات الصين بإفريقيا، حيث ينظر الكتاب إلى استثمارات الصين في مجالات برامج تنمية الموارد البشرية كأداة/فضاء لإنتاج المعرفة ونشر القيم الصينية (بالتركيز خاصّةً على مجالات الصحافة والتنمية والأمن). إضافة إلى ذلك، يستفيد الكتاب من المقاربة النظرية للباحث تْشِين يَاتْشِين (Qin Yaqing) عن النظرية الارتباطية (غوانشي) في العلاقات الدولية (Quanxi/Relational in IR).1
إنّ الفكرة الارتباطية (Relationality) تُعتبر أكثر الجوانب أهميّةً في سياسة الصين الخارجية. تقصد بها الكاتبة التركيز على الارتباطات بين الأشخاص (People-to-people Connections) كمفهومٍ مركزيٍ ووحدة للتحليل. وهو ما يتماشى مع ما يُركّز عليه عددٌ كبيرٌ من باحثي العلاقات الدولية الذّين يولون أهميةً للفكرة الارتباطية ويركّزون على هويّات الفواعل وأدوارهم التّي يشكّلون كعاملٍ محدّدٍ في العلاقات مع بقيّة الفواعل.
إستنادًا لهذا الإطار النظري يطرح الكتاب سؤالاً مهمًّا عن طبيعة التكنولوجيا والمهارات والخبرات والمعرفة المنقولة من الصين إلى بلدان القارّة الإفريقية. هل هي خاليةٌ من ديناميكيات السلطة/القوة؟ هل هي حيادية أم لا؟ ليجيب بأنّها غير حياديةٍ وتحمل معها أهدافًا سلطوية تسعى الصين لبلوغها في هذه الدول. تُخصِّص الصين، على سبيل المثال، منحًا للصحفيّين المهنيّين وطلبة الإعلام والصحافة في إفريقيا لأنّها ترى في أصحاب هذا التخصّص بمثابة الأفراد الذّين بإمكانهم رسم صورة الصين في إفريقيا. يتساءل الكتاب أيضًا عن السبب الذّي يجعل الصين ترفع من مستوى الاستثمار في برامج تنمية رأس المال البشري في إفريقيا حتّى حينما تَحدُّ من حجم قروضها وهباتها المالية للحكومات الافريقية؟ إلى أيّ مدى تُسهم عملية نقل المهارات وبرامج التدريب المهنية في ترويج نموذج التنمية والحكم الصيني باعتباره بديلاً عن النظام الليبرالي (الأمريكي-الغربي) يحظى بقابيلةِ التطبيقِ؟ كيف تتمظهر قوة/سلطة الصين في علاقاتها بالدول ما بعد الكولونيالية في الجنوب العالمي؟
إضافةً لسلوك طريقٍ مختلفٍ عن النظريات التقليدية في العلاقات الدولية عند دراسة السياسة الخارجية الصينية، تُبدي الكاتبة من البداية اختلاف تصوّرها عمّا يراه كثيرٌ من الباحثين بخصوص مدى اهتمام بيجين بالترويج لنموذجها في الخارج، فبينما لا يرى كثيرون بذلك كالواقعيّين خصوصا، ترى لينا بن عبد الله بأنّ الصين تسعى لترويج نموذجها في التنمية والحوْكَمَة لدى دول العالم، لاسيما دول الجنوب العالمي باعتباره بديلاً يمكن أن تلجأ إليه هذه الدول عمّا يُقدّمه نموذج النظام الدولي الليبرالي، غربيِّ التمركز والتوجّه والإيديولوجيا. لهذا تُموّل الحكومة الصينية عمليات تدريبٍ متنوّعة للنخب وتعمل على تشبيك العلاقات الاجتماعية مع المستثمرين ورجال الأعمال. لكنّ السؤال المُعقّد والمفتاحي المطروح هنا: هل تُصدِّر كلّ القوى الأساسية الكبرى، بما فيها الصين، نفوذها وقوتّها نحو الخارج بالطريقة ذاتها؟ أم أنّ الصين تفعل ذلك بطريقةٍ مختلفةٍ عن بقيّة القوى الكبرى الأساسية؟ تُحاجج الكاتبة بأنّ الأفضلية التنافسية للصين في سباقها حول النفوذ والجاذبية قد تمّ بناؤها على أساس توسِيع رأس المال الاجتماعي وشبكة العلاقات المهنيّة وقوة العلاقات مع النخب الافريقية، وتسعى في هذا الكتاب لتوضيح سبب وكيفية اعتبار رأس المال الاجتماعي وبناء شبكة العلاقات أمرًا مهمًّا من أجل تشكيل مستقبل القوة في السياسة العالمية.
تُشير لينا بن عبد الله في بداية الكتاب إلى طريقتها المنهجية الميدانية أثناء البحث في هذا الموضوع، حيث اعتمدت على حضور عددٍ من المنتديات والورش ذات الصلّة وإجراء مقابلاتٍ مع مسؤوليّين دبلوماسيّين وعسكريّين ونخب وصحفيّين أفارقة وصينيّين، خاصّة أثناء زيارتها لبيجين سنة 2014 وحضورها فعاليات “منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا” (FOCAC) (يُعقد كلّ ثلاث سنوات) الذّي ضمّ العديد من المسؤولين والدبلوماسيّين والموظفين الحكوميّين والنشطاء المدنيّين والصحفيّين والنخب الافريقية، حيث تُسجّل شهادتها عن ردود الفعل الإيجابية منهم بخصوص النموذج الصيني، فمثلما أخبرها أحد الدبلوماسيّين من رواندا: “سواءً أحببنا النظام الصيني أم لا، فإنّه نظام يشتغل ويَفي بالغرض”. حضرت الكاتبة قمّة المنتدى سنة 2018 أيضًا، كما أجرت زياراتٍ لـ مقر الإتحاد الإفريقي في أديسا بابا ومعهد كونفوشيوس الصيني هناك، إضافةً إلى زيارة كينيا وجيبوتي التّي يَظهر فيهما بشكلٍ لافتٍ تواجدٌ صينيٌ اقتصاديٌ وعسكريٌ على التوالي. كانت انطباعات المُحاورين لها عن برامج تَشاركِ المعرفة مع الأفارقة إيجابيةً للغاية. علاوةً على ذلك، قامت الكاتبة بزيارة مكتب “شبكة التلفزيون الصيني العالمي” في إفريقيا بكينيا وأجرت مقابلاتٍ مع فريقه ومذيعي الأخبار، وأيضًا زيارة المراكز الثقافية الفرنسية والألمانية المتواجدة هناك لغرض مقارنة طريقة عملها مع نظيرتها الصينية، كما تابعت -لأغراضٍ تحليلية- ما تنقله وسائل الإعلام الصينية والافريقية عن ما له صلةٌ بموضوع البحث. كلّ هذه الرحلات والملاحظات والوثائق الرسمية والمقابلات التّي تمّ إجراؤها قادت الكاتبة إلى فحص الروابط القائمة بين صناعة السياسة الخارجية وبناء شبكة العلاقات وإنتاج المعرفة وتصدير القوة نحو الخارج.
يحتوي الكتاب على مقدّمةٍ وسبعة فصول، يُمكن إعادة تقسيمها إلى أربع. يُعالج القسم الأول مسألة بناء شبكة الارتباطات في العلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا في الماضي والحاضر، بينما يتحدّث القسم الثاني عن الرؤية “الارتباطية” (Guanxi/Relationality)، رأس المالي الاجتماعي ومستقبل القوة. أمّا القسم الثالث فيدرس ثلاثة مجالات من العلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا بناءً على ما تُقدّمه “النظرية الإرتباطية” (Guanxi) من تبصّرات، وهي: مجال الدبلوماسية العسكرية والتدريب الأمني (الذّي يكتفي هذا العرض بتلخيصه كنموذج من بين المجالات الثلاث)، ومجال الدبلوماسية العامّة وتدريب الصحفيّين، ومجال الدبلوماسية الثقافية والدور الذّي تلعبه معاهد كونفوشيوس. يُقدّم القسم الأخير استنتاجاتٍ وخلاصاتٍ عن القوة الارتباطية ما وراء العلاقات الصينية-الافريقية.
i. بناء شبكة الارتباطات في العلاقات الصينية-الافريقية بين الماضي والحاضر:
تفحص لينا بن عبد الله هنا الأنماط المهمّة في صناعة السياسة الخارجية الصينية، كما تتَبَّع تاريخ الاستثمارات الصينية في مجال برامج التدريب المهني المُقدَّمَة للأفارقة، حيث تُظهر بأنّ هذا النمط من الاستثمارات ليس بالشيئ الجديد على الصين، فقد كان جزءًا من صناعة سياستها الخارجية منذ حقبة الزعيم الصيني ماو تسيتونغ، إلاّ أنّها تنامت من حيث الحجم والنطاق في الوقت الراهن. يُقدّم هذا القسم أيضًا خلفيةً من المعلومات الضرورية لفهم التحليل الذّي تُطوّره الكاتبة في الأقسام اللاحقة.
تُظهر الكاتبة في البداية مدى الاهتمام المتنامي للدول الافريقية بتوثيق علاقاتها مع الصين، حيث لا يُخفي قادة هذه البلدان مدى إعجابهم بالنموذج الصيني في التنمية والحَوْكَمة على حدٍّ سواء نظرًا لتشابه المشاكل التّي تعانيها كثيرٌ من هذه الدول مع المشاكل التّي عانتها الصين وتمكّنت من تجاوزها كمشكلة الفقر، ففي سنة 1978 بلغت نسبة السكان الصينيّين الذّين كانوا يعيشون تحت مستوى خطّ الفقر الشديد 90%، لتنخفض بشكلٍ رهيبٍ إلى 1% سنة 2014. مثل هذه النجاحات الصينية في تحقيق الاقلاع التنموي لابّد وأن تلفت انتباه العديد من بلدان الجنوب العالمي، بما فيها البلدان الافريقية، بل وصارت الصين نموذجًا جذّابًا للحوْكَمَة أيضًا، حيث تستفيد دولٌ عديدة، مثل كينيا، من توفير الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لمسؤوليها برامجًا ودوراتٍ تدريبيةٍ في الإدارة وكيفية القضاء على الفقر. من المفارقات أنّ نصيب الفرد من الدخل الوطني الاجمالي في كينيا كان سنة 1961 أعلى أربع مرّاتٍ مقارنةً بنظيره الصيني، أمّا اليوم فإنّ نصيبه يُقدّر بـ 1450 دولار في مقابل 8875 دولار لنظيره الصيني. لقد نما الدخل الوطني الإجمالي للصين بـ 50 ضعفًا، بينما نما نظيره الكيني بثلاثة أضعاف فقط. لمثل هذه الأسباب رأت هذه الدول ضرورةً في تركيز الانتباه على ما قامت به الصين بالضبط خلال الأربعين عامًا الماضية حتّى تتمكّن هي الأخرى من تجاوز مشكلات الفقر وترفع نسبة التنمية بها.
الأكثر من ذلك، تُظهر الدول الافريقية في الآونة الأخيرة اهتمامًا بالمؤسّسات الاقتصادية التّي تقودها الصين أكثر من اهتمامها بالمؤسّسات التقليدية التّي أنشأتها الولايات المتحدة ورعتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فشكّلت أساسًا لما صار يُعرف بالنظام الدولي الليبرالي. تُقدّم الكاتبة مقارنةً بليغة في هذا الصدد، ففي الاجتماع الـ 73 للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة المنعقد شهر سبتمبر 2018 بنيويورك، حضر 27 زعيمًا إفريقيًا، بينما شارك قبل أيام فقط من نفس الشهر 51 زعيمًا إفريقيًا في قمة منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا (FOCAC). لهذا الحضور دلالة على مدى اهتمام القادة الأفارقة بتعزيز العلاقات مع الصين أكثر حتّى من اهتمامهم بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تعهدّت الصين في هذه القمّة بتقديم حزمةٍ ماليةٍ بقيمة 60 مليار دولار كاستثمارات وقروضٍ وهباتٍ لتُصرَف في فترة السنوات الثلاث القادمة في إفريقيا، وهذا أحد الأساليب التّي تتبّعها بيجين لجذب كتلة الجنوب العالمي نحو مدارها، وعلى رأسها الدول الافريقية، حيث نجحت في أن تصير الشريك التجاري الأكبر لافريقيا منذ سنة 2009، وقد تجاوز حجم هذه الشراكة التجارية قيمة 100 مليار دولار مع نهاية سنة 2018.
- عن مبادئ السياسة الخارجية الصينية وإفريقيا:
من أجل تشكيل رؤيةٍ أشمل وفهمٍ أوضح للعلاقات الصينية-الإفريقية، تضع الكاتبة القرّاء في سياقٍ أعمّ للسياسة الخارجية الصينية ومبادئها الكبرى التّي تحكمها وتوجهّها في تعاملاتها مع الدول الأخرى، فمنذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة 1949 قامت سياسة البلد الخارجية على ما عُرف بالمبادئ الخمس للتعايش المشترك، وهي: مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي، عدم الاعتداء المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، المساواة والفائدة المتبادلة، والتعايش السلمي المشترك. ساعدت هذه المبادئ بيجين على تشكيل بيئةٍ مناسبةِ لمباشرة الاصلاحات المطلوبة داخل البلد والانفتاح على العالم الخارجي في ذات الوقت. أمّا في علاقاتها مع الجنوب العالمي فيُعتبر عدم الاعتداء ومناهضة الهيمنة مبدأيْن مركزيّيْن في سياسة الصين الخارجية، ولا تزال الصين تصف سياستها الخارجية بأنّها مناهِضةٌ للهيمنة بالرغم من تجاوزها لأغلب البلدان النامية من حيث عناصر القوة المختلفة.
في الحقيقة هناك ثلاث دوائرٍ وفضاءات مكانيةٍ كبرى تتمحور حولها السياسة الخارجية الصينية: 1. علاقات الصين مع القوى الكبرى (خاصّة الولايات المتحدة). 2. علاقات الصين مع دول الجوار القريب (اليابان مثلاً). 3. علاقات الصين مع البلدان النامية التّي تُشكّل ثلاثة أرباع بلدان العالم.
في علاقاتها مع البلدان النامية، لم تنخرط الصين بشكلٍ منظّم معها إلاّ مع مطلع تسعينيات القرن المنصرم. يعود ذلك جزئيًا إلى هيمنة السياسة الانعزالية الماويّة، كما يعود أيضًا إلى الرؤية الصينية المتمركزة على الذات والتّي هيمنت على صنّاع قرارها وجعلتهم ينظرون للصين باعتبارها مركز الكون وإلى البلدان الأخرى البعيدة عن المركز باعتبارهم برابرة وغير مثيرين للاهتمام. هكذا فإنّ السياسة الخارجية الصينية تجاه الدول النامية لا تزال –في نظر الكاتبة- في حالة اختبارٍ وترقّب نظرًا لتجربتها الحديثة في هذه الدول، منها الدول الافريقية، مقارنةً بالقوى الأوروبية التقليدية. كما ترى الكاتبة بأنّ سياسة الصين الخارجية تجاه الدول النامية عمومًا والافريقية خصوصًا قد تكشف لنا بشكلٍ أفضل ماهية الاستراتيجية الصينية الكبرى (ونوايا الصين) مقارنةً مع ما تكشفه لنا سياستها الخارجية في الدائرتيْن الأولى والثانية. هنا تكمن أهميّة متابعتها.
أ. الصين في عهد ماو وقيادة “العالم الثالث”:
هناك ثلاثة أسبابٍ رئيسية جعلت دول الجنوب العالمي مهمّةً بالنسبة للسياسة الخارجية الصينية، وهي: زيادة الدعم الدبلوماسي للصين وقضاياها، توسيع أسواقها، وبناء صورة حسنة لها عبر العالم. فنظرًا للعدد الكبير الذّي تمثّله دول الجنوب العالمي، فإنّ لأصواتها المؤيِّدة لقضايا الصين الحسّاسة في المنظمات الدولية أهميّةً حاسمة، على رأسها قضية تايوان. تُمثّل هذه الدول أيضًا سوقًا واسعةً للسلع الصينية ومصدرًا للموارد الطبيعية والخام التّي تحتاجها الصين في دعم مسار صعودها السريع. تُظهر الأرقام حرص الصين المتنامي على توثيق علاقات التعاون التجاري مع القارّة السمراء، فقد كان حجم التجارة الصينية مع إفريقيا في سبعينيات القرن العشرين أقلّ من مليار دولار، أمّا في سنة 2014 فبلغ 233 مليار دولار. أخيرًا، تُدرك بيجين بأنّ تجسيدها لبرامج التنمية في دول الجنوب العالمي سيُعزّز من صورة الصين الإيجابية هناك ويجعلها نموذجًا يُحتذى به لدى هذه الدول.
علاوةً على ذلك، تُلاحظ الكاتبة أنّه ومنذ ثمانينات القرن العشرين، أثمر التعاون بين الصين ودول الجنوب العالمي، الذّي كان يتّم في سياق إطار التعاون جنوب-جنوب، عن حدوث استقلالٍ نسبيٍ لدول القارّة السمراء عن التبعية للدول الكولونيالية المُتقدِّمة، وتنامي الاعتماد على دولٍ صاعدةٍ تنتمي للجنوب العالمي كالصين والبرازيل والهند، فضلاً عن تنويع اقتصادياتها وشركائها. هنا تطرح الكاتبة سؤالًا جوهريًا عن آثار هذا “الاعتماد الجديد” لدول الجنوب العالمي عمومًا، والدول الإفريقية بالأخصّ؟ هل يُعتبر مجرّد استبدالٍ لقوى كولونيالية قديمة بأخرى جديدة؟ وما هي ديناميكيات السلطة/القوة والتأثير في إنشاء معاهد كونفوشيوس لتعليم اللغة والثقافة الصينية بالجامعات الافريقية ومدارس الثانوية العامّة؟ وأيُّ نمطٍ من الهيراركية/الهرمية وديناميكية السلطة يتخلّل إطار التعاون جنوب-جنوب؟
ب. الدور الأدائي المزدوج للصين:
ترى الكاتبة بأنّ للسياسة الخارجية الصينية ميزةً فريدةً أخرى، تتمثّل في كونها تلعب دورًا مزدوجًا كبلدٍ نامي وكقوة كبرى في نفس الوقت. نظرًا لأنّ العلاقات هي التّي تُشكّل أدوار الفواعل وآدائهم بنفس القدر الذّي تقوم فيه هذه الفواعل بتشكيل العلاقات، فإنّ الدور الذّي تُلزم الصين به نفسها في سياقاتٍ مختلفةٍ يتنوّع من دورها كقوة صاعدة ذات علاقات مع القوى العظمى، إلى كونها قائدًا للعالم النامي. هذه المرونة في ممارسة الصين لهذه الأدوار جعلت الكاتبة تُناقش الصفة الفريدة لسياستها الخارجية التّي تجمع بين الالتزام بآداء دورٍ كقوة عظمى وآخر كبلدٍ نامي في نفس الوقت.
يؤكّد المسؤولون الصينيون على دور الصين كبلدٍ منتمي للبلدان النامية حينما يشعرون بالسخط تجاه النظام الليبرالي الجديد المُهيمَن عليه من طرف الغرب، ويدعون إلى إصلاح جوانبه التّي لا تتماشى مع خصائص الجنوب العالمي ومصالحه. تُسمّي الصين نفسها “أكبر بلدٍ نامي في العالم” حسب تعبير الرئيس شي جينبينغ. تُتابع السياسة الخارجية الصينية استراتيجيّتيْن في ذات الوقت. أولاًّ، تدعم بنشاط النظام الدولي الليبرالي القائم من أجل كسب الخبرة والشرعية كقوة مسؤولة فيه. أمّا الثانية، فتُصمّم عبرها بنشاط مبادراتٍ وتُروّج لها في البلدان النامية أساسًا كبرامج تسعى لتحقيق الازدهار والنمو لكلّ المشاركين فيها.
ج. مبدأ عدم التدخل الصيني: الاستخدام والحدود:
يُعتبر هذا المبدأ مبدءًا مركزيًا في سياسة الصين الخارجية، يعود الإيمان به إلى القرن الذّي تعرّضت فيه الصين للاعتداء من دول الجوار. تؤكّد الصين بموجبه على مبدأ احترام سيادة الآخرين وسلامة أراضيهم، وتجعل منه شعارًا لعلاقاتها مع الدول الافريقية (التّي عانت من الكولونيالية الغربية) منذ انفتاح علاقاتها الحديثة معها في مؤتمر باندونغ سنة 1955. يخدم الترويج لهذا المبدأ وحدة أراضي الصين وسلامتها التّي تعاني من نَزَعاتٍ انفصالية في إقليميْ التبت وشينجيانغ، وفي علاقاتها المتوتّرة عبر مضيق تايوان، كما تعاني مؤخّرًا من انقساماتٍ انتخابيةٍ في هونغ كونغ وتنامي الضغوطات عليها بخصوص أقليّة الإيغور وحقوق الإنسان.
تجد الكاتبة تعارضًا بين خطاب بيجين وممارساتها العملية لهذا المبدأ، فالصين التّي تؤكّد على هذا المبدأ في خطاباتها، تدخلّت في أكثر من مناسبة في الشؤون الداخلية لدولٍ افريقيةٍ عديدةٍ ولا تزال. تُقدّم الكاتبة أمثلةً عن ذلك، حيث ساعد جيش التحرير الشعبي الصيني مثلاً في تدريب جيوشٍ عديدةٍ في زنجيبار، داعمًا الجزيرة في حركتها الانفصالية عن الأرض الأم، تنزانيا (Tanganyika). لعب تزويد الصين للسودان بالأسلحة مؤخّرًا دورًا مهمًّا في نزاع الأخيرة ضدّ السودان الجنوبي، بل وإنّ “أسلحةً صينيةَ الصنع تمّ بيعها للسودان، حدث وأن سُرّبت أيضًا للمتمردّين في السودان الجنوبي” فوجدت الصين نفسها في موقفٍ محرجٍ حينما خرج الموضوع إلى العلن. علاوةً على ذلك، تدخّلت الصين كوسيطٍ نشط في أديسا بابا بين الفصائل المتحاربة هناك سنة 2014، وفي شهر مايو 2014، شاركت الصين في بعثة الأمم المتحدة لجنوب السودان بـ 314 جندي. أمّا في الأزمة الليبية فقد صوتّت بيجين لصالح تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية والتدخّل الأممي ضدّ نظام معمّر القذافي بعد استخدامه للقوة القهرية ضدّ شعبه في بنغازي، ولم تُصوّت ضدّ القرار باسخدام الفيتو مثلا، فكانت النتيجة هي التدخّل الكارثي لحلف الناتو في ليبيا. ترى بن عبد الله بأنّ قرار تَرك الصين لمرور هذا القرار الأممي بعدم التصويت ضدّه يُمثّل “ضربةً لشعار التضامن” مع الجنوب العالمي الذّي تروّج له الصين عن نفسها، لقد كان قرارها هذا “شوكةً خادشةً لسمعتها”.
تُشير الباحثة أيضًا إلى الدور الذّي لعبته صفقات الأسلحة الصينية وما تقدّمه بيجين من تدريباتٍ عسكريةٍ في دعم بعض الأنظمة الافريقية ضدّ معارضيها في الداخل. في سنة 2006 مثلاً أبرمت زيمبابوي بقيادة روبرت موغابي صفقةً مع الصين بقيمة 240 مليون دولار للحصول على مُعدّاتٍ عسكريةٍ وتدريبات، تمّ استخدامها من طرف نظام موغابي لإخماد أيّ معارضة له في الداخل. لقد حذّر موغابي المعارضة حينها بقوله: “فليحذر هؤلاء الذّين قد يُضمرون أيّ خططٍ للانقلاب على الحكومة: لدينا رجالٌ ونساء مسلّحين بامكانهم الضغط على الزناد.. لقد استفادت قوات الدفاع من سياسة النظر نحو الشرق التّي تبنّتها الحكومة (في إشارةٍ إلى الروابط الوثيقة بين حكومته والصين) والتّي لم تحصل بموجبها قوّاتنا على عتادٍ جديد فحسب، بل وتعلّمت استراتيجياتٍ عسكريةٍ جديدةٍ أيضًا”.
ترى الكاتبة ضرورةً في عدم فهم مبدأ عدم التدخل ضمن المجالات العسكرية والأمنية واقتصاره عليها فحسب، بل يجب توسيع هذا الفهم إلى المجالات الاقتصادية والثقافية أيضًا. إنّ التأثير على سلوك الدول من أجل القبول بمعاييرٍ وإجراءاتٍ جديدةٍ يُحتسب تدخّلاً أيضا، سواءً تمّ تنفيذ هذا التأثير تحت تهديد السلاح أو تمّ الاضطلاع به في المعاهد الثقافية. إنّ أمثلةً كهذه وغيرها تُعتبر في نظر الكاتبة شهادةً على محدودية قدرة الصين على تبنّي مبدأ عدم التدخّل.
- تقفّي أثر برامج التدريب المهني المُموّلة من الصين للأفارقة:
للصين تقليدٌ عريقٌ في مجال التجارة والتبادلات العلمية والثقافية منذ ما قبل نشوء الدولة الويستفالية، فيما عُرف بمملكة مينغ (Ming China). كانت الصين مركزًا لطرق التجارة على طول طريق الحرير الذّي بلغ مداه أوروبا وإفريقيا. يُرجع الأركيولوجيون التفاعل الأول بين الصين وإفريقيا إلى القرن الرابع عشر مُستندين في ذلك إلى عثورهم على عملةٍ نقديةٍ تعود لسلالة صونغ (Sung Dynesty) في جزيرة زنجيبار، كما عثروا على أخرى جنوبًا فيما يسمّى اليوم دولة “زيمبابوي”. لقد وصلت الصين هناك بفضل كشوفات الأميرال البحري الشهير “زينغ هي” (Zheng He) الذّي صار يُعتبر أيقونةَ الاكتشافات الصينية السلمية القديمة والتّي بلغت أماكنًا بعيدةً بهدف إرساء تبادلاتٍ ثقافيةٍ وتجاريةٍ مع الأمم الأخرى. يستحضر المسؤولون الصينيّون حاليًا الرحالات الاستكشافية السلمية السبع لـ “زينغ هي” للاشارة إلى العمق التاريخي للعلاقات الصينية-الإفريقية، ويؤكدّون بأنّ الصين وصلت إفريقيا قبل وصول القوى الكولونيالية الغربية إليها، مع ذلك لم تكن الصين –منذ القدم- قوةً كولونياليةً كهؤلاء، بل كانت قوةً مسالمةً تهدف لإرساء علاقاتٍ تبادليةٍ نافعةٍ للجميع. كلّ ذلك لتؤكّد بيجين على استمرارها في التعامل مع إفريقيا بذاتِ نهجِ الإرثِ التاريخي، وتؤكّد مسألة صعودها السلمي غير العدواني، خلافًا لما يدّعي الغرب.
تشير الكاتبة إلى أنّ فترة “سلالة مينع” وإكتشافات “زينغ هي” ليست إلاّ حلقةً مقتطعةً من تاريخٍ طويلٍ لا يتّم الاشارة إليه من طرف المسؤولين الصينيّين، فبعد تراجع “سلالة مينغ” ومجيئ “سلالة تشينغ” (Qing Dynasty) قطعت الصين علاقتها مع هذه الاكتشافات ومع العالم الخارجي، واتجهت نحو الانكماش على نفسها، فانحدرت علاقاتها مع إفريقيا بشدّة.
تُقدّم الكاتبة ضمن هذا القسم نبذةً مختصرةً عن الانقطاعات والتغيّرات التّي اكتنفت أولوية الصين الحديثة في علاقاتها مع الدول الإفريقية. فتُقسّم الدبلوماسية الصينية المعاصرة في القارة إلى ثلاثة حقبٍ أساسية: حقبة مناهضة الكولونيالية، والحقبة التنموية في السبعينيات، وحقبة ما بعد سنة 2000 (تاريخ انعقاد أول منتدى بين الصين وإفريقيا). تُسلّط هذه الحقب الضوء على السياسة الخارجية للصين تجاه الدول الافريقية من حيث الاستثمارات في تطوير الموارد البشرية، وتُوضّح كيف أبلت نجاحًا مع الزمن، كما تشرح دوافع الصين في اللجوء إلى هذا النمط من الاستثمارات في كلّ حقبة.
أ. برامج التأهيل المهني في حقبة التضامن ومناهضة الكولونيالية (خمسينيات وستينيات القرن 20م):
كانت الصين في هذه الحقبة داعمًا مهمًّا لحركات التحرّر ومناهضة الكولونيالية الغربية في إفريقيا. نبعت نزعة التضامن لدى نظام “ماو سيتونغ” من إيديولوجيته المناهضِة للعالم الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، ومن رؤيته للصين كقائدٍ لصراع الجنوب العالمي ضدّ الكولونيالية. أرست بيجين حينها طواقمًا تدريبيةً صينيةً في مجال الزراعة وفرقًا طبيّةً إلى سبع دولٍ إفريقيةٍ، منها الجزائر وموريتانيا والصومال، كما مولّت منحًا دراسةً لاستقدام طلبةٍ أفارقةٍ للدراسة في الصين. كانت داعمًا رئيسًا لمؤتمر باندونغ ومساندًا للروح الثورية التّي تسري في رؤية التعاون جنوب-جنوب.
كان مؤتمر باندونغ عام 1955 معلمًا رئيسًا لانفتاح العلاقات بين الصين وإفريقيا، إذْ فتح الأبواب أمامها للتعبير عن تشارك الطرفين في الرؤى المناوئة للكولونيالية والصراع ضدّها وتشارك أهداف التنمية. بعد المؤتمر صارت الصين أكثر انخراطًا واهتمامًا بدعم الحروب الثورية ضدّ القوى الكولونيالية في إفريقيا، كما حدث مع الجزائر وموزمبيق.
كانت الصين دومًا من بين الدول الأولى التّي تعترف بالأمم المستقلة عن الكولونيالية في إفريقيا، بل وأقامت علاقاتٍ دبلوماسيةٍ رسميةٍ مع الجزائر مثلاً حتّى قبل إستقلالها بأربع سنوات. ما بين سنتيْ 1960-1965، أنشأت الصين علاقاتٍ دبلوماسيةٍ رسميةٍ مع 14 دولةً إفريقية. تراجعت هذه العلاقات أثناء مرحلة “الثورة الثقافية” التّي عاشتها الصين ما بين 1966-1969 بسبب الغموض السياسي الذّي اكتنف وضع الصين الداخلي، فضلاً عن صراعها مع الاتحاد السوفياتي (الذّي كان داعمًا أيضًا لعدّة دولٍ إفريقيةٍ أيّام الحرب الباردة)، لكنّها عادت من جديد في حقبة السبعينيات.
ب. برامج التأهيل المهني خلال الحقبة التنموية للصين في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين:
حاولت الصين خلال هذه الفترة إعادة بناء مكانتها بين البلدان النامية وإصلاح علاقاتها مع هذه الدول وصورتها لديها بعد تراجعها أثناء فترة “الثورة الثقافية” وما سبّبته من تراجعٍ للثقة بها لدى هذه البلدان. تمثّلت إحدى سُبل فعلِ ذلك في استخدام الصين لآليات المساعدة المالية وزيادة التبادلات بين الشعب الصيني والشعوب الإفريقية، وزيادة حصّة المنح المُقدَّمَة للنخب الافريقية. في السبعينيات انتشرت الطواقم التدريبية الطبيّة الصينية في 22 بلدًا إفريقيًا، معظم المساعدات الصينية الخارجية لدول الجنوب العالمي كانت من نصيب إفريقيا ما بين سنتيْ 1970-1976، مُعوِضّةً الاتحاد السوفياتي كمصدرٍ رئيسٍ لمساعدات التنمية هناك.
كان هدف الصين في هذه الحقبة أيضًا هو استمالة كتلة دول الجنوب العالمي، بما فيها الدول الافريقية المستقلّة حديثًا، والتّي بدأت تأخذ مكانًا ما في النظام الدولي. لم تتعامل معها الصين كمجموعة بلدانٍ متخلّفة، بل كمجموعةٍ يمكن أن تُمارس فيها بيجين عملية بناء رأس المال الاجتماعي. كانت هذه الدول مهمّةً أيضًا لدعم موقف الصين في هيئة الأمم المتحدة تجاه قضية تايوان. في سنة 1971 تمّ التصويت على قرار قبول الصين في هيئة الأمم المتحدة بـ 76 صوتًا مؤيّدًا و35 صوتًا معارضًا و7 دول ممتنعة عن التصويت. كانت أصوات الدول الافريقية حاسمةً في نقل مقعد عضوية مجلس الأمن الدولي من تايوان إلى الصين.
عرفت العلاقات الصينية-الافريقية تراجعًا مرّةً أخرى في عهد الزعيم الصيني “دنغ شياوبينغ” حينما قرّر الأخير التركيز على التنمية المحليّة، كما كانت إيديولوجية دعم تنمية العالم النامي أقلّ أهميّةً بالنسبة له مقارنةً بسابقه. إستمر هذا الوضع إلى غاية مطلع التسعينيات.
ج. برامج التأهيل المهني ما بعد سنوات التسعينيات، وخطوات باتجاه قيادة “منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا” (FOCAC):
تنامت الانتقادات الغربية للحكومة الصينية والدعوات لفرض عقوبات عليها بسبب أحداث ساحة تيانانمين شهر يونيو 1989. نتيجةً لذلك، سحبت العديد من الدول بعثاتها الدبلوماسية من بيجين مُتسبّبةً في تضرّر سمعة الصين في الخارج، كلّ ذلك جعل بيجين تركّز جهود سياستها الخارجية مرّةً أخرى على تنمية علاقاتٍ أقوى مع البلدان النامية، خاصّةً في إفريقيا. لقد أدرك صنّاع السياسة الخارجية الصينية قيمة نسج علاقاتٍ عامّةٍ حسنةٍ مع هذه البلدان، فكان ذلك مَعلمًا آخر في تفاعل الصين مع الدول الافريقية. أدركت الصين أيضًا أنّ معظم القادة الأفارقة لم يكونو جزءًا من حملة الانتقاد التّي شُنت ضدّها في خضّم أحداث ساحة تيانانمين. عملت بيجين في هذه الفترة على زيادة التبادلات بين الصينيّين والأفارقة (People-to-people Exchanges)، وعلى تمويل المشاريع التنموية. كانت دومًا تستحضر ماضي التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة بين الطرفين، والقيم المناهضة للكولونيالية، وتؤكّد على تاريخها غير الكولونيالي الخالي من التدخّلات، خلافًا لماضي القوى الغربية.
كجزءٍ من هذه المرحلة الجديدة من الشراكة الإستراتيجية، لم تضع الصين أعينها على الاستثمار في تعزيز الروابط بينها وبين القادة الأفارقة في الوقت الحاضر فحسب، بل وعلى الجيل القادم من النخب الافريقية. إستخدمت بيجين أيضًا خليطًا من البرامج التدريبية المهنية التّي تُقدّمها مدارس الحزب الشيوعي الصيني في بيجين ومئات المنح للطلاّب الأفارقة حتّى تجعل العلاقات الرسمية بين الصين وإفريقيا أقوى. على سبيل المثال، تلقّى ما بين سنتيْ 2003-2015 ما لا يقلّ عن 63 ألف مهنيٍّ إفريقيٍّ تدريبات التأهيل المهني في الصين. بحلول سنة 2013، صارت الصين ضمن الدول الأربع الأولى في العالم المُقدِّمة لبرامج التدريب المهني إلى جانب الهند وألمانيا واليابان، إلاّ أنّها تمكّنت من تجاوز جميع هذه الدول منذ ذلك التاريخ.
- نطاق برامج تدريبات التأهيل المهني:
تُشير الكاتبة إلى وجود فرعٍ في وزارة التجارة الصينية يُسمّى بـ “أكاديمية مسؤوليِ الشؤون الدولية” (Academy for International Business Officials). تحظى الأكاديمية بقاعدة بيانات مُصنَّفة لكلّ برامج التدريب المهنية التّي تُموّلها الصين وتُقدّمها لأجل المسؤولين الأفارقة. تُتيح الأكاديمية للجميع إمكانية الولوج إلى هذه القاعدة، كما يُوجد أكثر من أربعين صنفًا من الورشات مُصنّفة ما بين مجالات الدبلوماسية والصحة والرياضة والزراعة والبنية التحية والإدارة العامّة والتعليم والفنّ وغيرها من المواضيع. تَظهر البرامج التدريبية في ثلاث تصنيفات بناءً على الفئة المستهدَفة المشارِكة: أ. برامج مُخصّصة لمسؤولين وزاريّين. ب. برامج مُخصّصة لموظفين مدنيّين في الدولة. ج. برامج مُخصّصة لمسؤولين غير رسميين. يحظى المسؤولين الأفارقة بنصيب الثلث تقريبًا من هذه البرامج (سنة 2013).
أجرت الكاتبة مسحًا تحليليًا لقاعدة البيانات لأغراضٍ بحثيةٍ عدّة، منها ملاحظة ما إذا كانت هناك علاقة ارتباطٍ ما بين البلدان التّي تستقبل معظم فرص برامج التدريب، والبلدان التّي تحوز على مواردٍ طبيعيةٍ أو مزايا جيوبولتيكيةٍ مهمّة بالنسبة للصين. فاستنتجت أنّه من الصعب الجزم بوجود علاقة مباشرة، ورأت بأنّ الصين تسعى فقط لتوسيع دوائر علاقتها والتفاعل مع العديد من ممثّلي الدول الافريقية قدر الإمكان. علاوةً على ذلك، تستنتج بأنّ برامج التدريب المهنية الصينية تقتصر لا على النخب السياسية والمهنية الإفريقية فحسب، بل تستهدف مجموعاتٍ واسعةٍ من الدبلوماسيّين وروّاد الأعمال والمعلمّين وخبراء الزارعة وغيرهم. كمثال عن ذلك، تشير الكاتبة إلى تعهّد الرئيس الصيني أثناء قمة “منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا” المنعقدة شهر سبتمبر 2018 بتقديم تدريب لألف فردٍ إفريقي واستضافة 50 ألف ورشة عمل في مجالاتٍ عديدةٍ وتوفير 50 ألف منحة حكومية وتمويل ألفيْ تبادل طلابي.
يهتّم هذا الكتاب بتسليط الضوء على دراسة حالة ثلاثة مجالات: المجال العسكري-الأمني، مجال فرق الإعلام والصحفيّين، والبرامج التدريبية المهنية الثقافية المُقدَّمة عبر معاهد كونفوشيوس.
ii. النظرية الارتباطية، رأس المال الاجتماعي ومستقبل القوة:
يُطوّر هذا القسم أُطرًا مفاهيميةً وتحليليةً مساعِدةً على تحليل دراسات الحالة التّي يختارها الكتاب في القسم الموالي. يُرتكز جوهر الإطار النظري هنا على ثلاثة مفاهيم: الإرتباطية (Relationality/Guanxi)، والانتاج المعرفي، ونشر/ترويج المعايير. تهتّم الكاتبة بالوجه الإنتاجي الارتباطي المُثمر للقوة. واعتمادًا على مفهوم “القوة الإرتباطية” (Relational Power) للباحث تشِيين ياتسين (Qin Yaqin) وتبصّرات ميشال فوكو عن الارتباط القائم بين القوة والمعرفة، وكذا الأدبيات التّي تنظرُ للمؤسّسات باعتبارها عاملاً مساهمًا في نشر القيم وترويجها وجعلها إجتماعية، تُقدّم الكاتبة إطارًا يُمكِّننا من فهم دور شبكة العلاقات الاجتماعية ورأس المال الارتباطي (Relational Capital) في صناعة السياسة الخارجية للقوى (الخارقة) الصاعدة (Rising “Super” Powers). إنّ فهم القوة (Power) من وجهة نظرٍ ارتباطيةٍ يجعلنا نُدرك بأنّ الفواعل تكون قويّةً بقدر ما لها من شبكة علاقاتٍ اجتماعية. وهنا يتّم قياس القوة والنفوذ من خلال النظر إلى زاوية رأس المال الاجتماعي، كما يتّم الأخذ بعين الاعتبار أسبقيّة العلاقات الاجتماعية على علاقات القوة. وحينما تصبح شبكة العلاقات الشخصية ورأس المال الاجتماعي رسميةً ومُمأسسةً فإنّها تتحوّل إلى فضاءاتٍ لانتاج المعرفة ونشر المعايير والقيم وطرق التفكير.
إنّ توسيع شبكة العلاقات والاتصالات وترويج التبادلات بين الشعوب يُعتبر أمرًا مركزيًا في استراتيجية الصين وإطارًا نظريًا مناسبًا لتحليل مدى اعتماد الصين على الرؤية الارتباطية في بناء آليات القوة. لهذا يهدف هذا الإطار النظري إلى شرح قسمٍ كبيرٍ من ممارسة سياسة الصين الخارجية، لكنّه لا يسعى للمُحاججة بعدم أهميّة مفاهيم القوة الماديّة في فهم القوى الصاعدة. إنّه يساهم في تكملة فهمنا للقوة في السياسة العالمية.
ترى الكاتبة بأنّ الصين “قوة كبرى” مختلفة في طبيعتها عن القوى الغربية الأخرى التّي عرفها التاريخ. إلاّ أنّ ذلك لا يعني بالضرورة عدم فائدة التنظير السائد أو التقليدي الخاصّ بالعلاقات الدولية في دراسة علاقات القوة الصينية مع الدول النامية، كما لا يعني إختلافُ الصين هذا أنّها بحاجةٍ إلى إطارٍ نظريٍ مختلفٍ للتحليل. لكن في نفس الوقت ترى الكاتبة بأنّ الثقافة تُشكّل العلاقات الاجتماعية وتصنع السياسة الخارجية بطرقٍ كبيرة.
إنّ المقاربات التقليدية التّي تُنَظِّر للقوة ليست كافيةً لفهم قسمٍ كبيرٍ من المسألة المتعلّقة بكيفية بناء القوى الصاعدة للنفوذ وتصديره نحو الخارج. ترى الكاتبة هنا بأنّ قسمًا كبيرًا من صناعة السياسة الخارجية والنفوذ الدولي في الصين يتمحور حول القدرة على توسيع شبكات العلاقات الاجتماعية وبناء علاقات قويّة بين الأفراد/الشعوب (People-to-people relations)، وتوسيع دوائر العلاقات. كنتيجةٍ لذلك فإنّ نظريات القوة التّي تقصر التركيز على قياس القدرات العسكرية أو الاقتصادية تفتقر للقدرة على حساب دور رأس المال الاجتماعي في السياسة الخارجية الصينية وتحليله. تؤكّد الكاتبة بأنّ تحليلها المُرَكّز على رأس المال الاجتماعي وشبكة العلاقات الارتباطية في بناء القوة وترويجها يجب أن يُنظر إليه كمُكمِّلٍ للنظريات التقليدية المفسِّرة للقوة في السياسة العالمية، لا كمنافس لها.
علاوةً على ذلك، تحاجج الكاتبة بأنّ الإطار النظري المُركّب الذّي استخدمته (المُشار إليه في بداية القسم) سمح لها بوضع ثلاث حججٍ مترابطة. أولا، إنّ شبكة العلاقات القائمة بين المسؤولين الحكوميّين رفيعي المستوى، والتدريبات العسكرية المشتركة وغيرها من العلاقات التبادلية بين الأفراد/الشعوب تُعتبر ممارساتٍ دبلوماسيةٍ تُعزّز شبكة العلاقات الارتباطية وتُوسّع النفوذ من خلالها. هذه البنى والأحداث تُعتبَر ممارَسةً للقوة ومقياسًا لها في نفس الوقت. ثانيا، إنّ نشاطات بناء شبكة العلاقات والتبادلات المتنوعة بين الأفراد/الشعوب هي فضاءات تبدأ بشكلٍ غير رسميٍ لكنّها قد تصير مُمأسَسةً من خلال التكرار وجعلها شيئًا روتينيًا. في الواقع، فإنّ صناعة السياسة الخارجية التّي تأخذ بعين الاعتبار العلاقات بين الأفراد/الشعوب والاستثمارات في رأس المال البشري بشكلٍ جدّي سوف تجعل في نهاية المطاف هذه الممارسات ممارساتٍ رسمية. ثالثًا، تُعتبر المؤسّسات مهمّةً لممارسة السياسة الخارجية لأنّها تسمح بتشكّل جماعاتٍ معرفيةٍ (Epistemic Communities) تُنتج معرفة متخصّصة (Expert Knowledge) وقيم ومعايير حول مواضيعٍ مرتبطةٍ بالحَوْكَمَة والتنمية والأمن، وهي شبيهةٌ بحزامٍ متحرّك ناقلٍ للمعرفة المتخصّصة المُنتجَة، ومساهمٍ في نشرها وترويجها، وكذا القيم والمعايير الناتجة عن التبادلات المتكرّرة والجماعات المعرفية.
ترى الكاتبة بأنّه في حالة القوى الصاعدة بالجنوب العالمي، فإنّ المعايير والقيم والمعرفة المتخصّصة المُنتَجة في هذه الحالات تُعتبر مهمّةً في دراسات العلاقات البينيّة، لأنّها بصدد وضع نماذج (غير غربية) بديلة وقيم للحوكمة والتنمية والأمن. لذا فإنّ الإطار النظري الذّي تطورّه الكاتبة عبر هذا القسم وتستخدمه طيلة أقسام الكتاب يرصد قوة رأس المال الاجتماعي وشبكة العلاقات الارتباطية في خلق فضاءاتٍ من أجل إنتاج ونشر معايير وقيم جديدة، ونماذج من شأنها أن تُروّج نموذج التنمية الصيني باعتباره بديلاً عن النظام الليبرالي المهيمن الذّي يقوده الغرب.
خلافًا للمفاهيم التقليدية عن القوة، تُحاجج الكاتبة بأنّ “القوة عبارة عن علاقة ارتباطية” (Power is relational)، فهي تشتغل وتتعاظم وتتراجع من خلال العلاقات. وفقًا للمقاربة الارتباطية للقوة، يكون الفواعل أقوياء بقدر ما تجعلهم شبكة علاقاتهم كذلك، فالفواعل ينشطون ويبنون ويُصدّرون القوة عبر علاقاتهم. تؤثّر العلاقات على القوة، كما أنّ نمط العلاقات التّي تحظى بها دولةٌ ما مع غيرها من الدول يمكنه أن يُقوّيها أو يُضعفها. يتقاسم الفواعل شبكة ارتباطاتهم وعلاقاتهم ويوسّعونها ويقوّونها من خلال الاستثمار أكثر في رأس المال الاجتماعي لأنفسهم ومن خلال تكثيف التداخلات مع دوائر العلاقات الخاصّة بالآخرين. من هذا المنظور فإنّ صناعة السياسة الخارجية (الصينية) ينبغي أن يُنظر لها على أنّها شبكة علاقاتٍ كثيفةٍ تُنتج القوة كما تُنتجها هذه القوة في المقابل. من خلال هذه العدسات النظرية، فإنّ العلاقات تسبق القوة، فالعلاقات ضرورية لتفعيل القوة ولكن القوة أيضًا تُنتج العلاقات وتقويّها من خلال مضاعفة رأس المال الاجتماعي عبر تكثيف شبكة العلاقات (أو عبر تقليصها).
ينقسم هذا القسم إلى ثلاثة أجزاء. يوضّح الجزء الأول سياق جدوى الفهم الراهن للقوة في حقل التنظير الخاصّ بالعلاقات الدولية. أمّا الثاني فيحاجج بأنّ العلاقات الاجتماعية تُولِّد القوة وفي المقابل تصير أقوى عبر ديناميكيات القوة، وبأنّ هذه الارتباطية (بالتحديد عبر مفهوم Guanxi) تُعتبر مفتاح مكانة القوة وتصديرها نحو الخارج وإبرازها. يُطبّق القسم الثالث هذا الإطار النظري الخاصّ بالقوة الانتاجية الارتباطية (المُثمرة) على العلاقات التفاعلية بين الأفراد/الشعوب (People-to-people relations) وعلى التبادلات المعرفية.
- القوة في نظرية العلاقات الدولية:
هناك نقاشاتٌ مختلفةٌ حول مصطلح القوة ودلالاته في العلاقات الدولية. تستخدم الكاتبة مقاربة ستيفن لوكيس (Stephen Lukes) عن “أوجه القوة” (The Faces of Power) كخطوة أوليّة لتطوير حجتّها، حيث تُناقش أوجه القوة المختلفة، مُوضّحةً نقاط القدرة والمحدودية فيها عند تفسير القوة في سياق ممارسة السياسة الخارجية للقوى (الخارقة) الصاعدة.
يستخدم لوكيس مصطلح “أوجه القوة” لوصف الجوانب المختلفة للقوة والتّي يراها مترابطةً ومعتمدةً على بعضها البعض. يتعلّق الوجه الأول للقوة بقوة السلوك القهري، والذّي يتّم به دراسة الحالات التّي يسعى فيها صناع السياسة الخارجية في بلد ما للتأثير على عملية صناعة القرار في بلد آخر. يركّز هذا الوجه عل تعريف روبرت دال (Robert Dahl) للقوة بكونها “قدرةُ فواعلٍ يحظون بالقوة على منع فواعل أخرى (لا يحظون بالقوة) من القيام بما يفضّل الأخيرين القيام به.” ترى لينا بن عبد الله بأنّ هذا البُعد ضيّق جيّدًا في تحديد ماهية القوة، قد يُطبَّق فقط في سياق صناعة القرار الخاصّ بالقضايا التّي تكون حول صراعٍ مرئيٍ وواضحٍ حول المصالح، وبالتالي فهو يفشل في كشف الطرق الأقلّ مرئية التّي تُمارَسُ فيها القوة.
أمّا “الوجه” الثاني للقوة، أي التحكّم في إعداد الأجندة، فيهدف إلى تدارك نقائص مفهوم روبرت دال للقوة في عدم أخذه بعين الاعتبار إمكانية تحكّم وسيطرة الفواعل في عملية صنع القرار. النقد الموجّه لـ دال هنا يتمثّل في كون نظرته للقوة تأخذ بعين الاعتبار قوة عمليات صنع القرار في مؤسّسةٍ محدّدةٍ مسبقًا فحسب، وهو ما يتسبّب في إهمال استراتيجيات تعبئة التحيّز ومنع مناقشة قضايا معيّنة، وبالتالي تحديد أيُّ القضايا هي مهمّة على طاولة المفاوضات، وأيّها مسكوتٌ عنها قبل وضع الأجندة. لذلك فإنّ نظرة دال للقوة لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنّ القوة يتّم توزيعها عادةً من أجل حصر نطاق صناعة القرار في قضايا “مُريحة” نسبيًا. طرح علماء السياسة الدولية تساؤلات حول هذا “الوجه” الثاني للقوة، بما فيها سؤالهم عن الكيفية التّي يتّم بها وضع الأجندات العابرة للدول، وكيف تتلاعب الدول ببلدانٍ أخرى ومنظماتٍ من أجل الحدّ من خياراتها. إلاّ أنّ هذه النظرة الناقدة لمفهوم دال هي نفسها مقتصرة على فحص القرارات الفردية التّي تُصنع من أجل الحيلولة دون أن تصير مطالب معينة تهديدًا من الناحية السياسية. فالتحليل العميق للقوة حسب الكاتبة، ينبغي أن يجعل نفسه أيضًا مهتّمًا “بكلّ الطرق المعقدّة والدقيقة” التّي تمنع فيها عوامل على غرار المؤسّسات ثقيلة الوزن مجموعاتٍ اجتماعيةٍ معيّنة من المشاركة في صنع القرار السياسي.
أمّا “الوجه” الثالث للقوة فيتمثّل في القوة الإيديولوجية. يذهب هذا الوجه إلى مدى أبعد من تحليل نزاعات المصلحة الظاهرة فيُولي انتباهًا للنزاعات القابلة للملاحظة والمخفيّة على حدّ سواء. يتّسم طرحيْ “المفهوم القهري للقوة” و”قوة التحكم في الأجندة” بقصور النظر في افتراض أنّ الصراع ضروري للقوة وبوجود حاجةٍ لأن يكون هناك نزاعُ مصالحٍ من أجل القوة يتّم ممارسته. حسب لوكيس فإنّ هذه المُسلّمة الفرضية تفشل في النظر إلى نقطةٍ حاسمة، وهي أنّ وجه القوة يكون في أغلب الأحيان أكثر فعالية من الناحية التكتيكية حينما يَحُول دون ظهور مثل هذه النزاعات حول المصالح في المقام الأول. تعتمد القيمة المُضافة لـ لوكيس بالتالي على تسليط الضوء على نمطٍ من القوة لا يظهر ليكون متنازعًا حوله أو قهريًا بشكلٍ مبالغٍ فيه، ولكن بدلاً من ذلك يتّم ممارسته عبر التفاعل. هكذا فإنّ القوة في إطاره النظري هي أداتية ويُنظر لها باعتبارها مقدرة يمتلكها فاعلٌ ما على الآخرين.
بناءً على ما سبق تُميّز الكاتبة مقاربتها النظرية عن مقاربة لوكيس، فالأخير يهتّم باستكشاف العلاقات الأداتية السببية بين الفواعل “أ” و”ب”. فما يُجبَر “ب” على القيام به (حالة الوجه الأول للقوة) يتسّبب فيه نفوذ “أ” على “ب”، ويمكن فقط فحصُه حينما يتّم التحقّق من العلاقات القائمة بين “أ” و”ب”. فالصيغة المفاهيمية للقوة في الإطار النظري لـ لوكيس تَفهم القهر باعتباره مقدرة ومِلكيّة، والتّي يكون الفاعل “أ” بموجبها قادرًا على تغيير سلوك “ب”، سواءً عبر القهر المباشر (الوجه الأول للقوة) أو عبر تشكيلٍ ضمنيٍ للأجندة (الوجه الثاني للقوة) أو عبر تشكيلٍ تكتيكيٍ لرغبات الفاعل “ب” ومصالحه لتتوافق مع رغبات ومصالح الفاعل “أ” (الوجه الثالث للقوة، وهو قريبٌ من مصطلح القوة الناعمة). القوة في هذه المقاربة متعلّقة بمقدرة “أ” على تحقيق مصالحه عبر قهر الفاعل “ب” بشكلٍ ضمنيٍ أو صريح، فهي أداةٌ يمتلكها “أ” أو “ب”.
في الوقت الذّي تركّز فيه مقاربة لوكيس على السبب والتأثير، ترى مقاربة لينا بن عبد الله القوة باعتبارها عمليةً، بدلاً من كونها مِلكيّة، وتنظر للقوة الارتباطية باعتبارها بناءً وإنتاجًا للمعاني والفواعل والعلاقات الأخرى، وللقوة أيضا.
- القوة الارتباطية والرؤية الارتباطية في التنظير للعلاقات الدولية:
تمّ الاهتمام بالقوة الارتباطية والرؤية الارتباطية في حقل التنظير الخاصّ بالعلاقات الدولية من طرف عدّة باحثين، لاسيما أولئك الذّين اهتموا بالنظر إلى ما هو أبعد من المدلول المادّي الأداتي للقوة، فظهرت في الدراسات النسوية مثلاً وما بعد الكولونيالية في العلاقات الدولية وغيرها من الدراسات المهتّمة بمسائل الهيمنة والعرق والطبقية والهجرة والمساواة، فهي تُعتبر رؤيةً جوهريةً في هذه الدراسات. إلاّ أنّ الكاتبة ترى بأنّ المقاربات ما بعد الكولونيالية والنسوية عن القوة الارتباطية تجعل مدلول القوة مُعبّرًا عن هيمنة المستعمِر على المستعمَر، وهيمنة طبقةٍ على أخرى، وهيمنة بنيةٍ عُليا على الوكالات ((“Super” structure over agents. مع أنّ مقارباتٍ نقديةٍ أخرى في النظرية ما بعد الكولونيالية تُحلّل الطرق التّي يمكن فيها للأطراف التّي تمتلك القوة أو الشعوب المُستعمَرة أن تُمارس الوكالة والقوة على الجهة القويّة التّي تبدو مهيمنة، كما ترى الكاتبة بأنّ القوة في معظم هذه الدراسات يتّم النظر إليها باعتبارها مِلكيّة لفاعل واحد يستخدمها للتأثير على الفواعل الأخرى ويُشكّل بها علاقات الهيمنة.
خلافًا لذلك، فإنّ مفهوم الارتباطية المُتبنّى في هذا الكتاب يرى بأنّ القوة تتموضع وتنتشر في التفاعلات البينيّة التّي تجري بين الفواعل المختلفة، كما تُفهم القوة هنا بكونها رأس مالٍ اجتماعيٍ وإنساني. بالنسبة للباحث الصيني في العلاقات الدولية تشيين ياتسِين (Qin Yakin) فإنّ الفرق الأكثر أهميّةً بين التيّار السائد في نظريات الدولية والرؤية الارتباطية في التنظير هو أنّ الأول غارق في نظامٍ معياريٍ قائمٍ على قواعد، بينما إبستيمولوجيا الارتباطية في حقل التنظير الخاصّ بالعلاقات الدولية تبدو متجذّرةً في الحوْكَمة الارتباطية.
إنّ القوة بماهيتها تعتبر ارتباطيةً، فبقدر ما تكون العلاقات قائمة بين الشبكات مكثّفة، بقدر ما تكون الفواعل قويّة. في هذه المقاربة فإنّ القوة الارتباطية هي مشابهة لكلّ من القوة الصلبة والناعمة، فهي القدرة على تغيير مواقف الآخرين ودوافعهم وسلوكاتهم، وبالتالي جعلهم يتماشون مع إرادة الفاعل أثناء عملية التفاعل الاجتماعي. فمثل هذه المصطلحات الارتباطية للقوة تقف على النقيض مع الرؤى التّي تنظر للقوة من حيث مصادرها أو أدواتها، ذلك أنّها تتواجد خلال العلاقات وفي خضمّها. تنطوي الرؤية الارتباطية أيضًا على عملية إدارة دوائر ارتباط الفاعل المعني والتلاعب بها لصالح أحد الفواعل. بناءً على ذلك، تُعتبر الفواعل السياسية أكثر قوةً حينما تنتمي إلى «دوائر ارتباطية أوسع، وأكثر صدقًا وقُربًا، وأكثر أهميّةً في هذه الدوائر، حيث تحظى الفواعل بمكانةٍ اجتماعية أكبر بسبب هذه الدوائر». لذلك فإنّ القوة الارتباطية «تُركّز على إدارة العلاقات بين الفواعل بدلاً من تركيزها على الفواعل في حدّ ذاتها». تتقاطع هذه الرؤية مع مفهوم البنائيّين الاجتماعيّين ومن شابههم، فالقوة بالنسبة لهم تُنتَج اجتماعيًا، وتُشكِّل قدرة الفواعل على تحديد مصيرهم.
فهم القوة الارتباطية واستخدامها:
تهتّم الكاتبة بالقوة الارتباطية الانتاجية المُثمرة2 في السياسة العالمية، وتعتمدها في شرح صناعة السياسة الخارجية الصينية، فهي تُعرّف القوة من زاوية نظر رأس المال البشري، مُستخدمةً مقاربة غوانشي (Guanxi) للسياسة العالمية. كما تحاجج الكاتبة بأنّ الممارسات الروتينية لبناء القوة الارتباطية (التبادلات بين الأفراد/الشعوب، إلخ) تقود إلى مَأْسَسَة هذه الممارسات، وهذا يوفّر فضاءً لصناعة المعايير/القيم، وإنتاج المعرفة المتخصّصة. علاوةً على ذلك واعتمادًا على ما يذكره الباحثون بخصوص دور المؤسّسات في نشر المعايير وصناعة الوعي المشترك، تفحص الكاتبة الآليات التّي من خلالها تُعتبر علاقات غوانشي الارتباطية وإنتاج المعرفة المتخصّصة (في سياق القوة الصاعدة “الخارقة”) فضاءاتٍ لنشر مجموعةٍ بديلةٍ من المعايير والقيم ونماذج التنمية والحوكمة وغيرها.
غوانشي (Guanxi):
تُقحم الكاتبة مفهوم “غوانشي” الصيني في إطارها النظري لفهم السياسة الخارجية الصينية. تقدّم له شرحًا مختصرًا في الثقافة الصينية عمومًا، ثمّ في العلاقات الدولية. يعني هذا المفهوم ببساطة “الارتباطات” (Connections) أو العلاقات (Relations) بلغة الماندرين. تمّ التعرّض للمفهوم من طرف باحثين كثر في ميادين مختلفة. منهم الانثروبولوجي مايفار يانغ (Mayfair Yang)، الذّي كتب دراسة مهمّة بعنوان “الهديّة، المعروف والضيافة” (Gift, Favors, and Banquets). يؤكّد فنّ غوانشي، بالنسبة له، على «قوة وشائج الصلّة ونوعية العاطفة والأخلاق في العلاقات الشخصية». فتقديم معروفٍ ما وفضلٍ أو هديّة أو ضيافة هي ممارساتٌ تُرسِي روابطًا شخصيةً وتوثّق عُرى الارتباط بين الضيوف والمُضِيفين من خلال المعروف والفضل، وتُنشِؤ رابطةً عاطفيةً وأخلاقيةً بينهم. لكن ما يُميّز الضيافة في فنّ غوانشي عن الأنماط الأخرى المشابهة هو «دورها كوسيطٍ للتبادل الاجتماعي، والأهمّ دورها الفاعل كوسيطٍ للتبادل الاقتصادي والسياسي ومدى قوتّها في ربط الضيف حتّى يرّد هذا الخير والمعروف». الضيافة في الثقافة الصينية، مثلما يشرح يانغ، «ليست مجرّد تكتيك في فنّ غوانشي، بل هي أيضًا شعيرة مهمّة في المجال الاجتماعي»… حيث «تجلبُ الضيافات جاهًا ومكانةً اجتماعيةً مُميّزة للمُضيفين».
بالرغم من أنّ فنّ غوانشي، حسب الدلالة المُشار إليها قبل قليل، كان متجسّدًا في حقبة حكم ماو تسيتونغ للصين، إلاّ أنّه لا يزال مستمرًا في صينِ اليوم حتّى بعد عقودٍ من الانفتاح على إصلاحات السوق منذ عهد الزعيم دانغ شياوبينغ، وفقًا للباحثة. خلافًا لذلك، هناك من الباحثين الدارسين لتطوّر هذا المفهوم في المجتمع الصيني يرون بأنّ انفتاح الصين على نظام السوق الحرّ جعلها تتحرّك صوبَ نظامٍ منقادٍ بالسوق، قائمٍ على الاستحقاق بدلاً من الارتباطات الاجتماعية، خاصّةً وأنّ نظام السوق المفتوح يقود إلى تنامي الشَرِكات الخاصّة على حساب تلك المملوكة للدولة. ترى الكاتبة خلاف ذلك، حيث يتميّز مفهوم غوانشي بالمرونة في نظرها، فمع خوصصة الشركات عرف المفهوم تناميًا، لا تراجعًا، إلاّ أنّ تضمين نُظمِ توظيفٍ قائمةٍ على الاستحقاق أدّى إلى تناقص أهمية غوانشي من دون أن يقضي على راهنيّته.
إنّ فهم طريقة عمل غوانشي على ضوء صعود قوة الصين يُعتبر موضوعًا جدليًا بين المنظّرين المعاصرين. هناك من يرى بأنّ دخول الصين إلى الأسواق الاقتصادية العالمية يُنقِص أهميّة تقليد غوانشي، فأرباب العمل ومسؤوليي الشرِكات يستقدمون موظفين بناءً على نظامٍ قائمٍ على الاستحقاق، لا على أساس تقليد غوانشي. لذلك سوف يتقلّص هذا “التقليد” ونفوذه إلى حدٍّ أدنى حينما تُطوِّر أنظمة السوق والقانون مناعةً أكبر. بينما يخالف آخرون هذا الرأي الذّي اقتصر على دراسة عيّناتٍ محدودةٍ جدًّا لا تعكس حقيقة توغّل غوانشي. فكثيرًا من ممارسات غوانشي تتّم خارج المكاتب وساعات العمل، فهي ممارساتٌ مرنة وليست ثابتة، وتتخّذ أشكالاً عديدةً، مملوسةٍ وغير ملموسة، بناءً على السياق المؤسّساتي المعني. وبينما كانت ممارسات غوانشي في الستينيات والسبعينيات تُركّز على الموارد الملموسة أكثر (المنتجات الغذائية وما شابه)، فإنّها تتخّذ اليوم أشكالاً عدّة، منها السمات الثقافية المجرّدة غير الملموسة.
غوانشي والارتباطية في العلاقات الدولية:
يُستخدم مفهوم غوانشي بشكلٍ واسعٍ في الدراسات الأكاديمية المتعلّقة بالتسويق والمالية والسلوك التنظيمي، وهي دراسات موجّهة عادةً للشركات غير الصينية التّي تقوم بأعمالها في الصين أو تسعى لذلك حتّى تفهم جيّدًا أهمية ممارسات غوانشي في هذه الشؤون. غير أنّ الكاتبة ترى بأنّ استخداماته قليلة جدًّا في دراسات حقل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، رغم تنامي الاهتمام بمكانة الصين في السياسة العالمية، وعلاقاتها بغيرها من الدول.
يَجري استقبال مفهوم غوانشي باهتمام متزايد في نظريات العلاقات الدولية، بالأخصّ في الأدبيات التّي تسعى لتطوير مقارباتٍ غير غربية أو تبحث فيها، مع ذلك فإنّ المفهوم يبقى من الناحية النظرية أقلّ تطوّرًا وأقلّ استخدامًا، كما أنّ الباحثين البارزين المهتمين به ركّزوا أكثر على ماهية القوة في هذه الرؤية، وأجابوا عن ذلك من خلال فحص الكونفوشيوسية وسمات الثقافة الصينية وغيرها، بينما لم يُمعِنو النظر في سؤال كيف تعمل القوة من وجهة نظر هذه الرؤية الارتباطية. أيْ أنّ تحليل ميكانيزمات بناء القوة من وجهة نظرٍ ارتباطيةٍ غائبٌ في هذا الحقل الأكاديمي. في هذا الكتاب، يُعتبر إنتاج المعرفة ونشر المعايير/القيم التّي تُسهلّها البرامج الارتباطية كبرامج التبادلات بين الشعوب مسألةً مركزيةً من أجل فهم ميكانيزمات بناء القوة وتصديرها نحو الخارج. إنّ تطوير مفهوم غوانشي بإمكانه أن يُثري فهمنا للقوة في السياسة العالمية نظريًا وتطبيقيًا. في هذا السياق فإنّ غوانشي هو تمظهرٌ وتجلّي لقوة العلاقات مع هدف زيادة رأس المال الاجتماعي لطرفٍ ما عبر وساطةِ بناء شبكة العلاقات ووشائج الارتباط والعواطف البشرية، هذا هو جوهر فكرة المقاربة الارتباطية للقوة.
ترى الكاتبة بأنّ منطق مفهوم الارتباطية بإمكانه أن يُقدّم فهمًا أكثر نجاحًا للمناطق التّي تتداخل فيها الجوانب الفكرية والمادية للسياسة الدولية، خلافًا للنظريات السائدة في العلاقات الدولية كالواقعية والليبرالية والبنائية التّي لا تحظى بهذه القدرة.
التفكير بخصوص مستقبل القوة في السياسة العالمية:
من وجهة نظر المقاربة الارتباطية يتّم تحديد موضع القوة وتفعيلها وتوسيعها في إطارٍ من العلاقات الاجتماعية. يسبق عامل العلاقات عامل القوة، بل وتُشكّلها في ذات الوقت الذّي يمكن للقوة المُولَّدة من خلال العلاقات أن تُقوّي شبكة العلاقات الاجتماعية وتُوسّعها في المقابل. وبدلاً من التساؤل عن ماهية القوة، تذهب الكاتبة للبحث في إظهار الميكانيزمات التّي من خلالها يُترجم رأس المال الاجتماعي وإرتباطات الشعوب ببعض إلى قوة (خاصّة في خضّم صناعة السياسة الخارجية). تتمثّل هذه الميكانيزمات في ذلك التداخل المتشابك المعقّد بين النفوذ المُطوَّر والمُوسَّع بواسطة رأس المال الاجتماعي، من خلال تبادلات الهدايا والمعروف والضيافات.
من وجهة نظر المقاربة الارتباطية الانتاجية للقوة، لا تتشكّل القوة قبل العلاقات، بل تنبعث من هذه العلاقات. تتواجد القوة بجانب العلاقات، فالعلاقات هي التّي تُحرّك القوة وتزيد منها. تتقوّى العلاقات بشكلٍ استطراديٍ وتُمارَس من خلال دبلوماسية ارتباطات الشعوب مع بعضها البعض والتبادلات الثقافية والاستثمارات في برامج التنمية البشرية. من وجهة النظر هذه، فإنّ المقاربة الارتباطية للقوة تمنح أولويةً للجوانب المعيارية وغير الماديّة والثقافية على حساب العناصر الماديّة أو الملموسة. وفقًا لهذه المقاربة، أن تكون قويًّا لا يتساوى مع كونك تحظى بأكبر وجودٍ عسكريٍ أو بحوزتك أكثر الموارد المالية. بدلاً من ذلك، فكونك قويًّا تُفهم بأنّك تحظى برأس مالٍ اجتماعيٍ قويّ وشبكة علاقاتٍ موسّعةٍ وتبادلاتٍ صلبة بين الشعوب. تتّم القوة، التّي تقع ضمن نطاق هذه العلاقات التعدّدية والمصالح المُأمنَّة، من خلال التلاعب بهذه العلاقات والمعروف/الفضل المتبادل والسلوكات القائمة على الردّ بالمثل. علاوةً على ذلك، تتمثّل الخطوة التالية الضرورية في النظر إلى رأس المال الاجتماعي باعتباره مجالاً يسمح بكلّ من تبادلات المعروف والهدايا ووشائج الارتباط الشخصية بين الناس المنخرطين، وأيضًا يسمح بانتاج المعرفة وتبادل الأفكار وصناعة المعايير والقيم.
3. العلاقات، المعرفة، شبكة الارتباطات والمؤسّسات:
ترى الكاتبة بأنّ أبحاث التنظير في العلاقات الدولية التّي اقحمت المقاربة الارتباطية في دراسة القوة والسياسة الدولية ظلّت تتجاهل إلى حدٍّ بعيد بعض الميكانيزمات التّي تقود العلاقات من خلالها القوة، وتتجاهل الكيفية التّي يتلاعب بها الوكلاء بالقوة الارتباطية هذه سعيًا منهم لبلوغ مصالحٍ ما. تصحيحًا لذلك تُظهر الكاتبة كيف أنّ جلبَ مقاربةٍ ارتباطيةٍ للقوة يُعتبر ضروريًا لفهم التطوّرات الراهنة داخل النظام الدولي مع صعود الصين وقوى الجنوب العالمي الأخرى. كما تكشف حلقة الصلّة بين المعرفة والقوة من أجل تحليل ميكانيزمات تصدير القوة في المقاربة الارتباطية للعلاقات الدولية.
لأجل تطوير هذه الميكانيزمات تقوم الكاتبة بمراجعة أدبيات التنظير في العلاقات الدولية التّي تفحص الكيفية التّي تتشكّل بها مصالح الدول والكيفية التّي تنشأ عبرها المعايير الدولية وتُنشر عبر المؤسّسات الدولية. تُورد الكاتبة بعض الأمثلة عن ذلك من الباحثين، لاسيما من البنائيّين، مشيرةً في نقدها لهم أنّ هذه الرؤى ظلّت تنظر غالبًا إلى المؤسّسات التّي يقودها الغرب والكيفية التّي تُعرِّف بها مثل هذه المؤسّسات مصالح الدول وتُشكّلها أو تنظر للكيفية التّي تخضع عبرها الدول النامية للتنشئة الاجتماعية في النظام الدولي من خلال الانضمام إلى المؤسّسات الدولية (كحالة تعرّض الصين للتنشئة الاجتماعية عبر منظمة التجارة العالمية). علاوةً على ذلك، فإنّ المنظمات الدولية ذات الصلّة بالمعايير التّي تمّ تحليلها في أبحاث التنظير الخاصّة بالعلاقات الدولية كانت في الغالب مؤسّساتٍ متناسبةٍ بشكلٍ ما مع النظام الدولي الليبرالي (كهيئة الأمم المتحدة واليونيسكو وصندوق النقد الدولي..)، فالمُسلّمة الفرضية هنا ظلّت تقول بأنّ المؤسّسات التّي يقودها الغرب تقوم بتنشئةٍ اجتماعيةٍ للجنوب العالمي وبقيّة الدول بشكلٍ يتماشى مع النظام الليبرالي الويستفالي الغربي، حيث يتّم النظر إلى دول الجنوب العالمي والدول النامية كطرفٍ مستهلِكٍ ومُستقبِلٍ، أو كطرفٍ مقاومٍ ومتحدّي لهذه المعايير الدولية في أحسن الأحوال.
تشير الكاتبة إلى ظهور دراسات تحاول تقديم وجهة نظر غير غربية للفواعل ولعملية التنشئة كالدراسات ما بعد الكولونيالية ورؤى الجنوب العالمي (كتلك المُركّزة على ثقافاتٍ محليّةٍ لدولٍ صاعدة: مثلاً، الصين ومفهوم Tianxia، أيْ “الكلّ تحت السماء“) والدراسات التّي تركّز عل مؤسّساتٍ صاعدة في الجنوب العالمي مثل مجموعة بريكس، كما توضّح الباحثة بأنّ كتابها يُعتبر مساهمةً لإثراء الحقل البحثي الموجود الذّي يتعامل مع نفوذ القوى الصاعدة ومبادراتها في إرساء مؤسّساتٍ لا تتحدّى النظام القائم فحسب، بل تصنع المعاييرًا وتمارس تنشئةً اجتماعيةً على الدول لتقبل بها باعتبارها خيارًا تفضيليًا على حساب الوضع القائم الذّي يمثّله النظام الدولي الليبرالي. فهذا الكتاب يفحص التداخل القائم بين رأس المال الاجتماعي وشبكة العلاقات وإنتاج المعرفة المتخصّصة وصناعة المعايير في المؤسّسات التّي تقودها الصين. فبما أنّ المنظمات الدولية تُعتبر حزامًا ناقلاً للمعايير الدولية، وبما أنّ منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا (FOCAC) هو عبارة عن مؤسّسة، فبالتالي يُمكن النظر إلى الأخير –بل وينبغي النظر إليه- باعتباره حزامًا ناقلاً للمعايير الدولية. لكن تبقى أهميّة معرفة ماهية هذه المعايير، ومعايير أيّ طرف بالضبط سوف تنشرها هذه المؤسّسة وغيرها من المؤسّسات التّي تقودها الصين، وعبر أيّة ميكانيزمات سيتّم إنتاج هذه المعايير وانتشارها.
حقول المعرفة وعلاقات القوة:
في صناعة السياسة الخارجية بإمكان العلاقات الاجتماعية وشبكة العلاقات التّي يتّم تعزيزها عبر التبادلات الشعبية الروتينية أن تنتقل من كونها شبكة علاقاتٍ ارتباطيةٍ غير رسمية لتصير شبكة مُمأسسة رسميًا. إنّ التبادلات والبرامج التدريبية المهنية تسمح عبر استمرار وتيرتها بتقاسم المعرفة المتخصّصة من المدرّبين والمُتدرِّبين بطرقٍ أكثر مؤسّساتية. في حالة السياسة الخارجية الصينية، فإنّ البرامج التدريبية التّي تعهدّت بها الحكومة الصينية خلال منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا صارت مُمأسسة من خلال وكالاتٍ محدّدة ومؤسّسات متواجدة في الصين تموِّل وتستضيف وتُنظّم هذه البرنامج التدريبية. توطّدُ وظيفة هذه المؤسّسات -كمنتجٍ للمعرفة- من رأس المال الاجتماعي ووشائج الصلّة الارتباطية. تُوطِّد المؤسّسات الرسمية من الروابط الاجتماعية التّي تشكّلت داخل شبكة العلاقات، كما تسمح بالتبادلات الروتينية للأفكار، ومشاركة النقاشات حول المشكلات ومشاركة التفكير بخصوص الحلول للمشكلات القائمة.
تتساءل الكاتبة، انطلاقًا ممّا سبق، كيف يتّم إنتاج المعرفة المتخصّصة واستيعابها وجعلها طبيعيةً بواسطة الفواعل الدولية وشرعنتها من طرف المؤسّسات الدولية؟ تُسلّط الأبحاث الموجودة بخصوص الجماعات المعرفية بعض الضوء على هذه العملية من خلال النظر إلى الجماعات المعرفية/الإبستيمية (Epistemic Communities). تُعرَّف الأخيرة ببساطة بكونها «شبكة علاقات لمهنيّين متخصّصين ذوي خبرة معترف بها وكفاءة في مجالٍ محدّدٍ وإدّعاء موثوق مرجعي بخصوص سياسات معرفية ذات صلة». تساعد الجماعات الإبستيمية في تحديد المصالح الذاتية لدولة ما وبإمكانها أن تلعب دورًا مهمًا في تحويل المعرفة والأفكار إلى سياسات. يمكن القيام بذلك من خلال ميكانيزمات نشر متنوعة. يُعتبر التعلّم المُؤسّسي أحد هذه الميكانيزمات، حيث يتعلّم الفواعل والوكلاء ويستوعبون المعرفة المُنتَجة والمُتشاركة من طرف الخبراء. يحدث التعلّم المؤسّسي «مباشرةً من خلال عملية الاقناع المتبادل بين الأشخاص والتواصل والتبادل والتأمّل». في هذه العملية تحدث تنشئةٌ اجتماعيةٌ من أجل القبول بالأفكار والقيم ووجهات النظر الجديدة.
همزةُ الوصل بين المعرفة والقوة (السلطة) باعتبارها إطارًا نظريًا لتحليل القوى الصاعدة:
تُشير همزة الوصل القائمة بين المعرفة والقوة (السلطة) إلى فهم القوة باعتبارها مبنيّة على المعرفة، ورؤية إنتاج المعرفة باعتبارها ممارسةً للقوة. (مثلاً يخضع المريض للطبيب وما يصف له من علاجٍ بمحض إرادته، فهو يخضع للخبرة المتخصّصة للطبيب التّي صارت تحمل سلطةً وقوةً معيّنة). هنا لا تُحدِّد القوة الاقتصادية والماديّة هذه العلاقة، بل الخبرة المتخصّصة هي التّي تُملي كيفية تفاعل الطرفين. حينما نُترجم هذه الفكرة إلى لغة السياسة العالمية، يتّم وصف المعرفة وقوة الخبرة عادةً بـ “الناعمة”، كونها تختلف تمامًا عن “القوة القهرية”. إلاّ أنّ الكاتبة لا تعتقد بأنّه من الضرورة أن يكون الأمر كذلك، حيث يمكن أن تكون المعرفة والخبرة عنيفةً تمامًا مثل القوة القهرية. عدم قابلية السمّة القهرية الخاصّة بالمعرفة والخبرة للملاحظة، ومظهر الصفة الناعمة لهما هو ما يجعل علاقة المعرفة-القوة تشتغل.
تعترف القوة الصاعدة ودول الجنوب العالمي، كالصين، وتشير في خطاباتها السياسية إلى إرث النزعة الكولونيالية وتاريخ استغلال القوى الأجنبية لبلدان العالم الثالث. بهذا المعنى فإنّ القوى الصاعدة أكثر حذرًا لا بخصوص المدركات السلبية للقوة القهرية فحسب، بل وتندّد بالممارسات الكولونيالية حتّى تضع مسافةً بين صعود قوتّها والقوى الأوروبية التقليدية، وتربط وتوثق عُرى العلاقات مع البلدان النامية وتبيّن بأنّهم زبائن محتملين لتكنولوجيّتها وأفكارها ومعاييرها وقيمها. هكذا، فإنّ تطوير شبكة علاقات اجتماعية قويّة، وتقوية وشائج الصلّة بين الشعوب يعتبر جزءًا حاسمًا في هذا الارتباط.
تقوم شبكة العلاقات الارتباطية بتعزيز بناء الثقّة بين القوى (الخارقة) الصاعدة وبقيّة الدول النامية. حيث تُقدّم هذه الشبكات لنخب الدولة والمسؤولين الحكوميّين مجموعةً جديدةً من القيم والمعايير حينما يتّم تنظيم برامج التدريب المهنية. إنّ فهم مركزية الفكرة الارتباطية وعملية إنتاج المعرفة المتخصّصة عبر التبادلات بين الشعوب وبرامج بناء الشبكات الاجتماعية يعتبر أمرًا أساسيًا من أجل فهم الصين كقوة (خارقة) صاعدة. تتجلّى هذه العلاقات في حالة السياسة الخارجية الصينية في حصص المنح المُقدَّمة للطلبة الدوليّين وبرامج التبادلات بين الشعوب في إطار مبادرة الحزام والطريق، وفي ورش العمل المشتركة وبرامج التدريب المهنية المُقدَمة للنخب والموظّفين المدنيّين الحكوميّين والضبّاط العسكريّين والمواطنين من مختلف البلدان النامية. تؤدّي كلّ هذه البارمج المقدّمة في مجالات مختلفة إلى إنتاج المعرفة المتخصّصة سواءً عبر الملتقيات وورش العمل أو التدريبات البحرية المشتركة.
إقتباسًا عن ميشال فوكو، ترى الكاتبة بأنّ «القوة والمعرفة يتضمّنان بعضهما البعض.. فلا وجود لعلاقة قوةٍ من دون توليفٍ وتركيبٍ متلازمٍ لحقلٍ معرفيٍ ما، ولا وجود لمعرفةٍ تستلزم مسبقًا وتتضمّن في ذات الوقت علاقات قوة».
أثناء إعدادها الميداني للكتاب، تشير الكاتبة إلى ملاحظاتٍ مهمّة، منها ملاحظتها عدم وجود مركزية عالية في صناعة السياسة الخارجية الصينية، فأثناء زياراتها الميدانية ولقاءاتها وحواراتها مع المسؤولين وغيرهم، لاحظت عدم وجود مكتب مُحدّد مكلّف بصياغة إستراتيجية الصين تجاه إفريقيا. بدلاً من ذلك، فإنّ المسؤولين العاملين في وزراة الشؤون الخارجية مرتبطين بسلسلةٍ طويلةٍ من القيادة، فكلّ من وزارة التعليم، وزارة التجارة، بنك الصين للتصدير والاستيراد، السفراء الصينيّين في البلدان الافريقية والضباط المسؤولين في وزارة الدفاع يُعتبرون لاعبين أساسيّين حينما يتعلّق الأمر بصياغة إستراتيجية الصين تجاه إفريقيا. الملاحظة الثانية تتمثّل في أنّ الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية تُعتبر جزءًا مُهمًّا من المقاربة الشاملة للانخراط التّي تتبعها السياسة الخارجية الصينية في إفريقيا.
ترى الكاتبة أيضًا بأنّ هناك ضرورةً لمعالجة الخطاب والممارسة في سياسة الصين الخارجية تجاه إفريقيا باعتبارهما مُنتجًا للتفاعل الذّي يحدث بين الصين والدول الإفريقية. في تركيزها على الخطاب الرسمي تُلاحظ الكاتبة تكرّرًا لعباراتٍ بعينها في خطابات المسؤولين الصينيّين بخصوص إفريقيا مثل “المنفعة المتبادلة”، “علاقات رابح-رابح”، و”الشركاء المتساوين”، فهي تُستعمل دومًا لتُعبّر عن الحكمة التقليدية للعلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا. إنّه لمن المهم النظر للخطابات باعتبارها مجالاً لإنتاج المعنى والممارسات الشفهية وغير الشفهية التّي تعقبها، فلطالما كان الخطاب عمليةً مهمّةً في إنتاج وإعادة إنتاج المعاني وتحويلها أيضا، بدلاً من مجرّد تثبيتها والاستقرار على دلالاتها.
يدرس القسم الموالي من الكتاب ثلاثة مجالات من العلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا بناءً على ما تُقدّمه النظرية الإرتباطية (Guanxi) من تبصّرات نظرية. تتمثّل هذه المجالات في: مجال الدبلوماسية العسكرية والتدريب الأمني، ومجال الدبلوماسية العامّة وتدريب الصحفيّين، ومجال الدبلوماسية الثقافية والدور الذّي تلعبه هنا معاهد كونفوشيوس. يكتفي هذا العرض بتلخيص المجال الأول وأبرز ما ورد فيه من أفكار، مُحفّزًا القرّاء على استكشاف المجالين الثاني والثالث عند قراءة الكتاب.
iii. “غوانشي” في الدبلوماسية العسكرية والبرامج التدريبية الأمنية:
في هذا القسم تُطبّق الكاتبة الإطار النظري سابق الذكر وتُحلّل على أساسه البرامج التدريبية التّي ترعاها بيجين وتُقدّمها للضبّاط العسكريّين رفيعي المستوى وقوات حفظ السلام ووكلاء الشركات الأمنية الخاصّة. يبدأ هذا القسم بفحص صياغة الخطابات المتعلّقة بالاستراتيجية الأمنية للصين في إفريقيا ويتابعها من خلال تحرّي الممارسات الأمنية المتنوعة المُطبّقة عبر برامج تدريب قوات حفظ السلام والبرامج التدريبية التّي تقدّمها الشركات الأمنية الخاصّة (الصينية) واللقاءات المنعقدة بين الضبّاط العسكريّين رفيعي المستوى وما يحدث بينهم من تبادلات. يُحاجج هذا القسم بأنّ التبادلات والبرامج التدريبية المرتبِطة بالمجال الأمني تُمثّل فرصةً للضبّاط العسكريّين الصينيّين من أجل توسيع ارتباطاتهم وبناء علاقاتٍ شخصيةٍ قويّةٍ مع نظرائهم الأفارقة. كما أنّ المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة تُمثّل أرضياتٍ مُساهِمةٍ في توسيع الروابط بين الصين والضبّاط العسكريّين الأفارقة رفيعي المستوى، شبيهة بالتحالفات.
تبدأ الكاتبة هذا القسم بالإشارة إلى بعض التحذيرات التّي تلقّتها وكالة الأمن القومي الأمريكي من طرف نوّاب ومسؤولين أمريكيّين بخصوص عزم جيبوتي منح قاعدةٍ عسكريةٍ للصين بإحدى موانئها البحرية هناك، وما يمكن لذلك أن يؤثّر سلبًا على مصالح الولايات المتحدة وأدوارها وميزان القوة في القرن الإفريقي. تُوضّح بن عبد الله بأنّ القاسم المشترك بين هذه التحذيرات كونها تنظر لتهديد الصين من ناحيةٍ عسكرية (كإعاقة نشاط الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب) أو من ناحيةٍ مالية (الوقوع في فخّ الديون مثلاً)، إلاّ أنّها تفشل في فهم أنّ أغلب الروابط العسكرية التّي أقامتها الصين مع الدول الافريقية جاءت عبر شبكة علاقاتٍ مدروسةٍ بشكلٍ مفصّل تشمل التبادلات العسكرية الثنائية والمنتديات الدفاعية وبرامج تدريب للعناصر الأمنية الإفريقية.
أصدرت الحكومة الصينية أول ورقةِ سياساتٍ بيضاء لها بخصوص إفريقيا سنة 2006، وهي وثيقة رسمية تُوضّح الخطوط العريضة لإستراتيجية السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا، وذلك بالتزامن مع عقد قمّة منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا (FOCAC). تمّ تحديث الورقة سنة 2015 مع عقد ثاني قمّة لذات المنتدى. عبر تحليلٍ سريعٍ لمضمون الورقتين، تُلاحظ الكاتبة بأنّ كلمة أمن (Security) (بمعناه الذّي يشير إلى الاستقرار) تمّ الإشارة إليها خمس مرّاتٍ في الوثيقة الأولى لسنة 2006، بينما تمّ الإشارة إلى كلمة “إرهاب” مرّة واحدة. بعد مرور حوالي عقدٍ من الزمن، وردت في الورقة الثانية لسنة 2015 كلمة أمن 15 مرّة (في سياق مدلوليْ السلام والاستقرار)، بينما تمّ الإشارة لكلمة “إرهاب” خمسة مرّات، وفي ذلك إشارة لوجود تنامي سريع في الاهتمام بمسائل الأمن والسلام في العلاقات الصينية-الإفريقية.
تُشير الكاتبة أيضًا لوجود تنامي أكاديمي صيني-إفريقي في الاهتمام بموضوع التعاون الأمني من زوايا مختلفة، مُشيرةً إلى أمثلةٍ من كتابات باحثين عديدين عن مساهمة الصين في جهود بناء السلام، وكيف ينعكس ذلك على صناعة المعايير والقيم وإتبّاع هذه المعايير، وأخرى عن دور الصين في تسوية النزاع في جنوب السودان، والجدل القائم بين الباحثين بخصوص مدى تعزيز الصين لمبدأ عدم التدخّل في إفريقيا، إلخ. لكن ما يغيب عن هذه التحليلات هو إظهار بناء العلاقات المتمحورة حول الأشخاص في العلاقات الأمنية بين الصين وإفريقيا. تُعتبر استثمارات الصين في البرامج المهنية المُقدَّمة للضبّاط العسكريّين وقوات حفظ السلام وأفراد الشركات الأمنية الخاصّة جانبًا حيويًا في العلاقات الأمنية الصينية-الافريقية، مثلما تُحاجج الكاتبة.
وبالرغم من توسيع الصين للتعاون في مجال السلام والأمن مع الدول الإفريقية، إلاّ أنّ الوجود الصيني في إفريقيا لم يبلغ بعد مستوى نظيره الأمريكي، حيث تُشرف واشنطن على مبادرة القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) والمقترنة بإجراء عملياتٍ عسكريةٍ بالطائرات المُسيَّرة، كما تتواجد الولايات المتحدة في القارّة السمراء بقرابة 1500 ضابط و34 مركزًا عسكريًا. في الحقيقة فإنّ العمليات العسكرية الفرنسية في الساحل، وحتّى التعاون المتقدّم التّي تضطلع به الهند في مجال المراقبة البحرية مع الدول الافريقية الجُزُرية يبقيان أوسع نطاقًا من الاستثمار الصيني في هذا المجال. لذلك ترى الكاتبة بأنّ تزايد النمو الصيني والأشكال المختلفة الذّي يتّخذه يعكس وجود حاجةٍ إلى استكشاف التداعيات الكامنة لبناء شبكة علاقاتٍ اجتماعيةٍ قويّة وارتباطاتٍ شخصيةٍ بين الضبّاط الصينيّين رفيعي المستوى والبحرية الصينية والشركات الأمنية الصينية الخاصّة من جهة، والنظراء الأفارقة من جهة أخرى. تتجلّى الروابط القويّة بين الأشخاص وما بين الضبّاط الصينيّين والأفارقة في الزيارات رفيعة المستوى وبرامج التدريب التقنية والدبلوماسية العسكرية المتبادلة والتدريبات المُقدَّمة من طرف الشركات الأمنية الصينية الخاصّة المتواجدة في إفريقيا.
باستخدام الإطار النظري السابق عن ماهية القوة وكيفية عملها وعن الرؤية الارتباطية أيضًا، تُحلّل الكاتبة ثلاث حالاتٍ لفرصِ التدريب التّي ترعاها الصين وتُقدّمها لصالح القوات العسكرية الإفريقية والعناصر الأمنية، فتُقدّم أولاً نظرةً عامّةً عن التنامي التدريجي للاستثمار الصيني في قطاع الأمن في إفريقيا. تُحلّل، ثانيًا، برامج التدريب المهنية المُمولّة من الصين والمُقدَّمة لصالح الأمن الإفريقي والعناصر العسكرية، خصوصًا التدريبات المُقدَّمة للضبّاط العسكريّين رفيعي المستوى والعاملين بمجال حفظ السلام وفرق الشركات الأمنية الخاصّة. ثالثًا، تُطبّق الإطار النظري المتعلّق بالقوة الارتباطية وتُحلّل أَثَرَ هذه التدريبات من منظور شبكة غوانشي وإنتاج المعرفة الخاصّة بالنظريات الأمنية وإجراءات عمليات الاستجابة للتهديد. وتُنهي هذا القسم باستكشاف فعالية استثمارات الصين في رأس المال البشري بمجال الدبلوماسية العسكرية في إفريقيا.
إذا كانت القدرة تصنع الحقّ، فما الذّي يصنع القدرة؟
ما بين سنتيْ 2013 و2017 باعت الصين أسلحةً لـ 48 بلدًا، مُحتلةً المرتبة الخامسة في قائمة أكبر مصدّري الأسلحة الكبرى، إذْ بلغت حصّة مساهمتها العالمية في تصدير السلاح نسبة 5,2% ما بين 2014 و2018 مقارنةً بـ 36% تمثّلها الولايات المتحدة من سوق السلاح المُصدَّر عالميًا. كما أنّ الصين من بين أول خمس دول مستوردة للسلاح في العالم، وهو ما يظهر بأنّها أحد أكبر المستهلكين لتكنولوجيا السلاح عالميًا بدلاً من كونها منتجًا لها.
يُحاجج باحثون كثر بأنّ للصين نفوذًا عسكريًا هامشيًا في إفريقيا بسبب وجود قواتٍ صينيةٍ قليلةٍ هناك مقارنةً بأمريكا أو فرنسا أو غيرهما. في هذا الصدد تؤكّد بن عبد الله بأنّ معايير مقارنةٍ كهذه تخضع لعوامل ماديّةٍ محضة (ترتكز عليها المقاربات التقليدية الواقعية أساسًا)، في حين أنّ طبيعة الممارسات الأمنية للصين في إفريقيا تختلف كميًّا ونوعيًّا عن تلك الخاصّة باللاعبين الأساسيّين الآخرين هناك. لذلك فهي ترى أنّ مثل هذه المقاربات التقليدية الواقعية الماديّة تُقدّم قيمةً تحليليةً محدودةً في تحليل جوانبٍ غير ملموسةٍ للسياسة العسكرية والأمنية الصينية تجاه إفريقيا كتلك التّي أوردتها الكاتبة مرارًا في الفصول السابقة (على غرار خلق شبكة علاقات قويّة بين الضباط العسكريّين رفيعي المستوى في جيوش الطرفين، إنتاج معرفةٍ مخصّصةٍ من أجل فهم التهديدات والاستجابة لها وفُرص نشر المعايير/القيم أثناء تقديم برامج التدريب المهني والمناورات المشتركة، إلخ). وحينما ننظر إلى الاستراتيجية الأمنية للصين في إفريقيا من منظورٍ محدودٍ يتمحور حول الامكانيات العسكرية وبيع السلاح، فإنّ المرء سينتهي لاستنتاج أنّ المصالح الأمنية الصينية منقادة بدوافع إقتصادية، ومُحدَّدة بحماية سلاسل توريد الطاقة الصينية والمصالح التجارية. إلاّ أنّ ذلك سيُنتج إهمالاً لقسطٍ كبيرٍ من السياسة الخارجية الصينية في إفريقيا، والتّي تُخصّص اهتمامًا كبيرًا لرعاية شبكة علاقاتٍ اجتماعيةٍ وارتباط الناس ببعضها البعض عبر برامج التدريب المهني وزيارات الرسميّين.
- الدور المتنامي للصين في أمن إفريقيا: تحليلٌ للخطاب:
يمكن لمقاربةٍ ارتباطيةٍ إنتاجيةٍ أن تُساعدنا على فهم تنامي استثمار بيجين في المنتديات الأمنية-الدفاعية والزيارات والتبادلات القائمة بين ضبّاط رفيعي المستوى وتدريبات حفظ السلام والمناورات البحرية المشتركة مع النظراء الأفارقة رغم تقلّص الانفاق المالي.
تُحلّل الكاتبة فقرةً وردت في أول ورقةٍ بيضاء أصدرتها وزارة الشؤون الخارجية الصينية بخصوص إستراتيجية الصين الافريقية سنة 2006. ورد فيها بأنّ: «الصين سوف تُعزّز التبادلات العسكرية رفيعة المستوى بين الجانبين وتضطلع بإجراء تبادلاتٍ وتعاونٍ تكنولوجي-عسكري. سوف تستمر في المساعدة على تدريب العناصر العسكرية الافريقية ودعم بناء الدفاع والجيش للبلدان الافريقية من أجل أمنهم الخاصّ».
تلاحظ الكاتبة وجود عنصريْن جديريْن بالانتباه في هذه الفقرة. يتعلّق الأول بتأكيد الصين على الزيارات والتدريب والتبادلات بين الأفراد. أمّا الثاني فيتمثّل في تأكيد الصين على إمساك إفريقيا بزمام الأمور في تعاونها الأمني معها. تعكس الفقرة ضمنيًا الاستراتيجية الأمنية الصينية في إفريقيا، والتّي تلتزم بتشجيع الأفارقة على بناء الدفاع من أجل أمنهم الخاصّ. يُغذّي الخطاب الأهداف الواسعة لسياسة الصين الخارجية الساعية إلى تصوير الصين باعتبارها قوةً أجنبيةً لا تسعى لبناء وتشكيل أمن الأفارقة أو ممارسة النفوذ عليهم. يوجد أيضًا تأكيدٌ صارمٌ في الخطاب الرسمي الصيني المتربط بالتعاون الأمني على حُرمة مبدأ عدم التدخل. حيث تُصوّر بيجين التدخّل في النزاعات الإفريقية الجارية باعتباره ممارسةً تتصّف بها الدوافع الأوروبية الاستعمارية في القارّة، خلافًا لأهداف الصين المُفكِّكة للكولونيالية والمُناهضة لها. تحرص الصين عبر خطاباتها الرسمية على إظهار اختلافها عن القوى التقليدية الأوروبية والغربية، وبأنّها لا تملك أيّ دوافعِ هيمنةٍ أو إمبريالية في إفريقيا. يتّم تأطير مسألة تدريب الكوادر/الموظفين والمحافظة على زياراتٍ تبادليةٍ نشطة بين الفرق العسكرية في صيغة خطابٍ يؤكّد على دعم البلدان الافريقية في بناء “أمنها الخاصّ”. هذه النقطة كانت مشتركة في الخطابات الرسمية الصينية لقمم منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا ما بين سنتيْ 2009-2012، فمثلما ورد في قمة FOCAC لسنة 2009:
«تُثمّن الحكومة الصينية مفهوم ‘حلّ مشكلات الأفارقة بواسطة الأفارقة’ وتدعم ممارساته، كما تستمر في دعم جهود الاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى والبلدان المعنيّة في حلّ النزاعات الإقليمية، وستُكثّف التعاون مع البلدان الإفريقية في الأبحاث النظرية لحفظ السلام، وتدريبات حفظ السلام والتبادلات، وفي دعم بناء قدرات حفظ السلام في إفريقيا».
تؤكّد الصين أيضًا على مبدأ “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية” حينما يتعلّق الأمر بتسوية النزاعات. يأتي الدعم الصيني لهذه الجهود عبر أشكالٍ مختلفة: تبرّعات بمعدّات وتدريب موظفين/كوادر وتوفير المساعدة اللوجيستية (كدوريات المراقبة البحرية التّي تجريها الصين في خليج عدن لمواجهة القرصنة البحرية)، ومهمات حفظ السلام. يأتي ذلك دومًا مع لغة خطابٍ صينيٍ مؤكّدةٍ على مبدأ عدم التدخّل واحترام السيادة، وذلك من أجل ترسيخ تصوّر لدى الآخرين عن كونها قوة صاعدة بشكلٍ سلمي، تريد أن تعمل مع البلدان الأخرى بدلاً من الإستئساد عليها أو تشكيلها أو السيطرة عليها. كما بدا حرص الصين وتأكيدها على هذه الرؤية أكثر وضوحًا في قمّة سنة 2005 بناءً على تحليل خطاب التوصيات التّي خرجت به القمة وفقًا للكاتبة. علاوةً على ذلك، تُظهر الصين في خطابها الرسمي وأجندتها خلال قمّة FOCAC لسنة 2015 وغيرها من القمم بأنّها تربط بين التنمية والأمن في سياستها الأمنية تجاه إفريقيا، فهي تؤمن بأنّ الفقر والتخلّف يُعتبران جذران رئيسيّان للنزاعات الجارية في إفريقيا، لهذا فهي تربط في أجندتها وخطاباتها الرسمية بين التنمية وتقليص الفقر وخلق ظروف حياةٍ أفضل من جهة، وبين تعزيز السلام والاستقرار من جهةٍ أخرى.
- “غوانشي” في الدبلوماسية العسكرية: برامج التدريب المُقدَّمَة لفرق الجيوش الإفريقية:
يشيد القادة الأفارقة مرارًا بالصين لدورها في تقديم برامج تدريبية مهنية وفنيّة للموظفين/الكوادر الأفارقة خلال لقاءات الـ FOCAC. في سنة 2015 طلب رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما من بيجين، في كلمته الافتتاحية للمنتدى (المنعقد في بلاده)، أن تُقدّم مزيدًا من هذه البرامج التدريبية. أمّا القيادة الصينية فعادةً ما تستجيب بترحيبٍ لمثل هذه الطلبات لأنّها تنطوي أساسًا على مخاطر أقلّ واستثمارات غير مكلفةٍ ذات إمكانيات عالية لتوسيع نطاق القوة الارتباطية. في قمّة FOCAC لسنة 2018 أعلن الرئيس الصيني تشي جينبينغ أنّ هدف القمة هو تدريب ألف فردٍ إفريقي وإستضافة 50 ألف ورشة عمل وتقديم 50 ألف منحة حكومية وتمويل ورعاية 2000 تبادل طلابي، وهي أرقامٌ أعلى من تلك المقرّرة في قمّة سنة 2015. تشمل مواضيع التدريب في المجال الأمني الزيارات الرسمية والمناورات المشتركة وتدريب المنشغلين في مجال حفظ السلام وتقديم تدريبات لموظفي الأمن الخاصّ.
أ. برامج التدريب العسكرية وزيارات قادة الجيوش:
تُشير لينا بن عبد الله لوجود أكثر من 20 معهدًا أكاديميًا وتدريبيًا في الصين يستضيف تدريباتٍ عسكريةٍ للضباط الأجانب. في خمسينيات القرن الماضي أنشأت جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني قِسمًا متخصّصًا في التدريب الأجنبي. درّب القسم آلافًا من الضبّاط الأجانب ينتمون لحوالي 100 دولة. في سنة 2004 أُعيد تشغيل القسم وصار معهدًا جديدًا يحمل تسمية “معهد الشؤون الدفاعية”. في السنة ذاتها كان للمعهد برنامج دروس عن الشؤون الدولية حضره أكثر من 970 ضابط أول في الجيش ينتمون لأكثر من 40 بلدًا. تُقدّم جامعة الدفاع الوطني الصينية بشكلٍ مستمر دروسًا تدريبية للضبّاط العسكريّين الأفارقة. وفقًا لآخر تقرير فإنّ: «لكلّ جيشٍ إفريقيٍ على الأقل كولونيل أو جينيرال واحد متخرّج من هذه الجامعة». يشير هذا الأمر بالنسبة للكاتبة لوجود روابط قوية وشبكة غوانشي بين ضبّاط الجيش الصينيّين ونُظرائهم الأفارقة، كما يُشير إلى اعتياد الضباط المشاركين في هذه التدريبات على أنماط العمليات العسكرية والفلسفة العسكرية وسُبل فهم التهديدات والاستجابة لها من وجهة نظرٍ عسكريةٍ صينية.
تُرسل الصين دعواتها للكوادر العسكرية الافريقية للمشاركة في برامج التدريبات المُقامة في الصين أو تُرسل مُمثّليها إلى هذه الدول من أجل تنظيم تدريبات خلال مدّة محدودة. على سبيل المثال، في شهر مايو 2020 شارك 15 ضابطًا رفيع المستوى من 15 بلدًا إفريقيًا لمدّة 12 يومًا في برنامجٍ تدريبيٍ بالصين تمّ تنظيمه بشكلٍ مشتركٍ بين أكاديمية العلوم العسكرية وجامعة الدفاع الوطني الصينيّتين. تشير الكاتبة إلى مثالٍ آخر حينما استضافت وزارة الدفاع الصينية أول منتدى بين الصين وإفريقيا عن التعاون الدفاعي والأمني، والذّي ضمّ ضبّاطًا عسكريّين من أكثر من 50 بلدًا إفريقيًا ولمدّة أسبوعين. لهذا المنتدى دلالات عديدة، منها إشارته لقوة العلاقات العسكرية التّي يحظى بها المسؤولين العسكريّين للصين مع نظرائهم الأفارقة. كما تشير مدّة الأسبوعين لوجود فرصة زمن طويلة نسبيًا تتيح تقاسم الخبرة والعلاقات والحوارات المهنية والشخصية بين الطرفين أكثر ممّا تمنحه اللقاءات الرسمية القصيرة التّي تجري عادةً في يومين أو ثلاث. فهو فضاءٌ لاشتغال شبكات غوانشي والاستثمار في رأس المال الارتباطي وبناء روابط الثقّة والصداقة.
تشير لينا بن عبد الله إلى أنّ بعض برامج التدريب العسكري تُجرَى بشكلٍ روتيني منتظم في الصين كلّ فترة. مثلاً تُرسل أنغولا ثلاثين عنصرًا من فريقها العسكري كلّ سنة لتحصيل تدريبٍ عسكريٍ في الصين. كما يشارك حوالي 18 مسؤولاً في قوات الدفاع البتسوانية سنويًا في برامج تدريب مُقامة بالصين، وغيرها من الأمثلة. أمّا مواضيع البرامج التدريبية فهي متنوعة كالتدريب على المعدّات والتكتيكات والاستراتيجيات ومواجهة الجوائح وحالات الكوارث الطبيعية وغيرها، كما توجد أيضًا برامجٌ ومحاضراتٌ عن دور القيم الكونفوشيوسية الصينية في تشكيل العلاقات المدنية-العسكرية. كمثالٍ آخر تذكر الكاتبة بأنّ الأكاديمية الصينية للشرطة الخاصّة نظّمت برامج تدريبية للفنون القتالية لصالح مسؤولين عسكريّين تابعين للاتحاد الإفريقي حتّى تعرض عليهم القيم الصينية والمفهوم الصيني للعلاقات المدنية-العسكرية. أشار الكاتب زاو لي (Zhao Lee) في تقريرٍ لصحيفة دايلي الصين شارحًا بأنّ التدريب تضمّن قسمين: قراءة الكتاب الكلاسيكي “فنّ الحرب” لـ صان تزو، وتعلّم التدريبات التكتيكية في الأكاديمية. ذكر الضابط العسكري الجزائري المشارك في هذا التدريب للكاتب زاو لي بأنّه: «حتّى وإن كانت التكتيكات في هذا التدريب ترجع لآلاف السنين، إلاّ أنّ بعضًا منها قابلٌ للتطبيق في الشؤون العسكرية اليوم». هكذا فإنّ المتدرّبين الأفارقة خضعوا لا لتدريباتٍ حول المسائل العسكرية (الماديّة) الصينية فحسب، بل تعرّفوا أيضًا على طرق التفكير الصينية بخصوص مسائل الحرب والأمن والاستراتيجية والإرهاب.
تشير الكاتبة لوجود جانبٍ آخر حيوي في التدريبات التّي تحدث خارج غُرف الملتقيات، حينما يتّم تنظيم جولات حول الصين لهؤلاء المتدرّبين العسكريّين الأفارقة ويُظهر لهم الصينيّين مدى حداثة وتطوّر وقدرة الصين، وكيف تمكّنت من تحقيق كلّ ذلك خلال فترة قصيرة من الزمن. كلّ ذلك يضيف قِيمًا مهمّةً للتجربة، فضلاً عن تجوّلهم في المنشآت العسكرية الصينية والمدن العصرية الضخمة. تُرسّخ التجربة في أذهان الضيوف صورةً إيجابيةً عن الصين ونموذجها الناجح الذّي يمكن أن يكون قابلاً للمحاكاة في بلدانهم.
إنّ برامجًا تدريبيةً كهذه موجّهة للضبّاط والملحقين العسكريّين الأفارقة من شأنها أن توسّع شبكة العلاقات وتوسّع من ممارسات تقليد غوانشي في مجال العلاقات العسكرية بين الطرفين. يُعتبر فهمُ هذا الجانب الارتباطي أمرًا مفتاحيًا لفهم كيف يتّم تشكيل علاقات القوة في السياسة الخارجية الصينية بإفريقيا.
ب. قوة “غوانشي” في البرامج التدريبية المُوجَّهة للمنشغلين بقوات حفظ السلام:
ترعى الصين برامج تدريبٍ عسكريةٍ مهنية مُقدّمة للمسؤولين والقوات الأمنية الإفريقية المُشارِكة في عمليات حفظ السلام تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة. حيث تشارك بعثات حفظ السلام الصينية في تقديم برامج تدريبية للقوات الأمنية المحليّة وكذا لقوات حفظ السلام التّي تُعتبر جزءًا من المهمات التّي يقودها الاتحاد الإفريقي. على سبيل المثال، أرسلت الصين إلى مالي وحدةَ قواتِ حمايةٍ مكونّةً من 170 جندي، ووحدة مهندسين مُشكّلةً من 155 جنديًا، ووحدةً طبيّةً تضّم 70 جنديًا. قامت وحدة المهندسين باختبار بناء الطرق، وإصلاح وتركيب 667 منزلاً جاهزَ الصنع. أمّا وحدة قوات الحماية فأجْرَت 2710 دوريةَ مراقبةٍ مسلّحةٍ ومهمّةٍ أمنية، في حين عالجت الوحدة الطبية 8120 مريضًا. هكذا فقد عُرفت قوات حفظ السلام الصينية في مالي بمقاربتها الشمولية ذات الجوانب المختلفة للاقتصاد والصحّة والتنمية الاجتماعية، هذا ما جعل السيد موسى مارا (Mousa Mara)، رئيس وزراء سابق لدولة مالي، يقول: «تُعتبر قوات حفظ السلام الصينية لا قوة سلامٍ فحسب، بل قوة تنميةٍ أيضا. لقد أدركوا بأنّ حفظ السلام لا يعني التسليح وإرسال الجنود فحسب، ولكن يعني أيضًا تطوير سُبل العيش للمحليّين. لقد فازت قوات حفظ السلام الصينية بقلب الشعب المالي”.
تُعتبر الصين اليوم المُوفِّر الأكبر لقوات حفظ السلام بين كلّ أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين بهيئة الأمم المتحدة. فمنذ أن شرعت الصين سنة 1999 في المساهمة في جهود حفظ السلام أخذ موضعها يتغيّر من فاعلٍ كابحٍ للمهمات بمجلس الأمن الدولي على خلفية مبدأ عدم التدخّل، إلى فاعلٍ مساهمٍ نشطٍ من خلال عناصره والتمويل المُقدَّم لجعل هذه المهام أكثر نجاحًا. حوالي 10% من ميزانية عمليات حفظ السلام الأُمميّة تموّلها بيجين، محتلّةً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في هذا الصدد.
في سنة 2018 شارك الصينيون المشتغلون بمهام حفظ السلام في 9 عمليات حفظ سلامٍ أُمميّةٍ من أصل 15 حول العالم، وفي 7 من أصل 8 عمليات تمّت في إفريقيا. أمّا عدد أفرادها المنشغلين في قوات حفظ السلام والمنتشرين في إفريقيا فيتجاوز عدد نظرائه الأمريكيّين والبريطانيّين والفرنسيّين والروس. وهو ما يعني أنّ بإمكان الصين أن تقدّم حجّةً أقوى لالتزامها الصادق بالمحافظة على علاقاتٍ وديّةٍ مع الشُركاء الأفارقة.
يتلقّى الصينيّون العاملون في مجال حفظ السلام إشاداتٍ حسنة من السلطات المحليّة للدول التّي ينتشرون فيها ومن الاتحاد الإفريقي وهيئة الأمم المتحدة، حيث يتميّزون بجهودهم الإبداعية جدًّا في انخراطهم، وهم يتلقّون إشادات حسنة أيضًا بسبب تدريبهم للمحليّين على طرقٍ سهلةٍ وفعّالةٍ تساعد على تحسين ظروف عيشهم.
إنّه لمن المهم، كما تؤكّد الكاتبة، أن يتّم وضع هذه الجهود الصينية في سياق الانطباعات الإيجابية لعلاقات غوانشي ونقل المعرفة، خاصّةً للسكان المحليّين، وهو مسألةٌ نابعةٌ من التدريبات التّي يُقدّمها الصينيّون المنشغلون بمجال حفظ السلام.
ج. إنتاج المعرفة المُختصّصة والشرِكات الأمنية الخاصّة:
تُقدِّم الشركات الأمنية الصينية الخاصّة برامج تدريبٍ مهنيّةٍ للقطاع الأمني الخاصّ. في سنة 2017 استأجرت مجموعات الشركات الأمنية الخاصّة ما لا يقلّ عن 3200 موظّف من الخارج (في ذات السنة كان عدد القوات الصينية المنشغلة بمهام حفظ السلام تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة يبلغ 2600 شخصًا). وهو ما يشير إلى منح الصين أهميّةً بالغةً لهذا القطاع النامي بوتيرةٍ أعلى. يتواجد نشاط هؤلاء المتعاقدين الأمنيّين الخواص عادةً في مناطقٍ ذات مخاطر نزاعية عالية وتضّم استثمارات صينية أيضا. حيث تنتشر الشركات الأمنية الصينية لتأمين الاستثمارات الصينية في إفريقيا منذ انطلاق مبادرة الحزام والطريق سنة 2013، وهي تستمر في التوسّع. تستأجر الشركات الصينية المملوكة للدولة شركاتٍ أمنيةٍ صينيةٍ خاصّة لحماية فِرقها ومصالحها خاصّةً في الأماكن النزاعية، وهو ما تراه الكاتبة طريقةً خلاقّةً تحافظ بها الصين على التزامها بمبدأ عدم التدخّل وما يتبعه من جلبٍ لقوات جيشها إلى البلدان الافريقية، وتحافظ به في ذات الوقت على سلامة شرِكاتها ومصالحها هناك.
للشركات الأمنية الخاصّة العاملة في هذه البلدان صلاحيات قانونية وإجرائية أوسع، مثلاً، فإنّ ضبّاط البحرية العاملين في شركة هووا شين زونغ (Hua Xin Zhong)، وهي شركة من بيجين، لهم صلاحيات استخدام القوة الفتّاكة كإجراءٍ دفاعيٍّ ذاتيٍّ ضدّ القراصنة كما تنصّ عليه عقود عملهم هناك، بينما لا يمكن لحرّاس البحرية الصينية إلاّ إطلاق نيرانٍ تحذيريةٍ إذا لم تكن سفنهم الحربية تحت هجومٍ مباشر.
ترى الكاتبة بأنّه كلّما زادت استثمارات الصين في مناطق النزاعات عاليةَ الخطورة، كلّما واجهت تحدّياتٍ جسيمةٍ تجعلها تستقطب مشاركة الشركات الأمنية الخاصّة (الصينية) لحمايتها. على سبيل المثال، حينما تعاقدت “شركة الجسر والطريق” الصينية المملوكة للدولة من أجل بناء خطّ سكّةٍ حديديةٍ يربط العاصمة الكينية نيروبي بالساحل في مدينة مومباسا، قامت بنشر عناصرٍ أمنيةٍ خاصّةٍ مُستقدَمةً من الشركة الصينية الأمنية “ديوي” (Dewei). كانت إحدى مهام هذه الشركة الأمنية في كينيا تقديم دوراتٍ تدريبيةٍ عديدةٍ للعملاء الأمنيّين الكينيّين في معارك الفنون القتالية. فمن معارك الفنون القتالية إلى ندواتٍ استراتيجيةٍ عن الأمن، تسعى الشركات الأمنية الصينية الخاصّة لملئ فجوةٍ أمنيةٍ يتسبّب فيها عادةً عدم التمويل الجيّد للجيوش الإفريقية، أو عدم التدريب الجيّد أو قلّة عناصر هذه الجيوش.
تشير الكاتبة إلى أنّ هذه الشركات الأمنية الخاصّة (الصينية) ليست في الحقيقة شركات خاصّة محضة، بل هي شركاتٌ مملوكةٌ للحكومة ومُتحكّمٌ فيها من طرفها، وتمارس وظيفتها تحت قيادة الحزب الصيني الشيوعي بنفس قدر جيش التحرير الشعبي الصيني. إيجاد هذه الشركات من طرف بيجين ما هي إلاّ طريقة للتحايل على مبدأ عدم التدخّل وتجنّب أيّ صفاتٍ سلبيةٍ قد يُلصقها الخصوم بالوجود الصيني في إفريقيا، كوصفه بـ “التدخّلي” أو “العدواني”.
من حيث المنشأ، تُعتبر هذه الشركات جديدةً، يعود تاريخ إنشائها لسنة 2010 بعدما أصدرت الحكومة الصينية قانونًا يتيح تأسيسها وعملها داخل الصين أو خارجها. وقد كان هناك إقتراحٌ من طرف أحد المسؤولين الصينيّين بإنشاء نسخةٍ صينيةٍ عن شركة “بلاك ووتر” الأمريكية تكون مستعدّةً للانتشار على المستوى العالمي لتوفير الحماية المسلّحة للشركات الصينية التّي تشتغل في المناطق الخطيرة حينما يحين الوقت، إلاّ أنّ اقتراحه وُوجِه بانتقاداتٍ شديدةٍ داخل الصين. مع ذلك، فإنّ الشركات الأمنية الخاصّة الصينية ظلّت تعرف تناميًا من حيث عددها ونشاطاتها خارج الحدود، على غرار شركة “جينكيز للاستشارات الأمنية” (Genghis Security Advisory) التّي أرسلت 400 عنصرًا أمنيًا لحماية الشركات الصينية المتواجدة في الخارج، بما فيها تلك المتواجدة في الجزائر وليبيا، وفقًا لما ذكرته وكالة تشينهوا للأنباء (Xinhua News Agency). كما أورد التقرير انخراط هذه الشركة في تدريب القوى المحليّة. عادةً ما يتّم ذلك، وفقًا للصينيّين، حينما لا تكون الدولة المُستضيفة قادرةً على حماية الشركات الاقتصادية الصينية واستثماراتها ورعاياها، فيتّم الاتفاق بين الصين وهذه الدولة على التعاون المشترك (عبر الشركة الأمنية الخاصّة والمؤسّسة المعنية بالشراكة في الدولة المستضيفة) على نشر قوات أمنية لتدريب القوات المحليّة ومساعدتها على بناء قدراتها.
تتساءل الكاتبة عن أيّ قيمة تضيفها استثمارات الصين في تدريب الكوادر الأمنية الخاصّة للدول الإفريقية، وعن التداعيات المترتبّة عن هذه التدريبات على السياسة الأمنية الصينية في إفريقيا؟
ترجع الكاتبة إلى أحد أعمال الباحثة أنا ليندر (Anna Leander)، حيث تتحرّى الأخيرة الدور الذّي تلعبه الشركات العسكرية الخاصّة في تشكيل الخطاب وفهم السياسات لموضوع الأمن. من خلال اعتمادها على مقاربة “أوجه القوة” للباحث لوكيس (خاصّةً الوجهان الثاني والثالث لها)، وجدت بأنّ مثل هذه الشركات: «تُشكّل التأويلات المتعلّقة بالأمن من خلال دورها الذّي لا يمكن إهماله في التدريب والاستشارة ضمن القوات المسلّحة والدولة في الشؤون الأمنية داخل الديار وخارجها».
أثناء التدريبات العسكرية والأمنية التّي تقدّمها الصين (وشرِكاتها الأمنية الخاصّة)، فإنّ إنتاج وتشكيل الفهم الصيني للأمن ونقله للنظراء الأفارقة يكون أمرًا ممكنًا. فمن خلال تنشئة القوات الأمنية الافريقية على المعايير والقيم الصينية ومن خلال المعرفة المتخصّصة وفهم ماهية الأمن وكيفيّة مواجهة التهديدات الأمنية، سيصير بإمكان القوات العسكرية الصينية والإفريقية التواصل على ذات الخطّ فيما يتعلّق بقضايا السلام الدولي والأمن. فحينما يتّم تركيزُ انتباه المتدرّبين على استخدام أنماطٍ محدَّدةٍ من المُعدّات أثناء التعامل مع أوضاعٍ ذات نمطٍ محدّد، فمن المرجح أنّ يتّم تأويل مثل هذه الأوضاع حينما تظهر بطرقٍ مشابهةٍ في المستقبل وسيتّم الاستجابة لها بنفس الطريقة.
تُشير الكاتبة إلى أنّ التدريبات التّي تقدّمها الشركات الأمنية الخاصّة للأفارقة والتّي ترعاها الصين، تتيح للأخيرة فرصةً لخلق أسواقٍ تجاريةٍ لمعدّاتها العسكرية وأسلحتها الثقيلة وبيعها للشركاء الأفارقة، وهو ما يُحقّق للصناعة العسكرية الصينية أرباحًا، كما يجعل الصين من الدول الأولى المُصدّرة للسلاح في إفريقيا.
وممّا يساعد هذه الشركات على كسب زبائنٍ أوسع هو قلّة تكلفة استئجارها مقارنةً بتكلفة استئجار نظيراتها الأمريكية والغربية. كمثالٍ على ذلك، فإنّ استئجار 12 عنصرًا أمنيًا من إحدى الشركات الأمنية الصينية الخاصّة المتواجدة في شرق إفريقيا يُكلّف حوالي 570 دولار لليوم الواحد، بينما يُكلّف استئجار 4 عناصر حراسة من شركات غربية ما يفوق 4 آلاف دولار لليوم الواحد.
تُنبّه الكاتبة كاستنتاج، بأنّ الانطلاق من مقاربة القوة الارتباطية يجعلنا لا نرى نقص تواجدِ البصمة العسكرية الصينية في إفريقيا، من حيث عدد القواعد العسكرية أو الحضور الميداني للجنود، بأنّه دليلٌ على الدور الهامشي للصين في النشاطات الأمنية والدفاعية بالقارة. بدلاً من ذلك، فإنّ مقاربة القوة الارتباطية تجعلنا نُسلّط الضوء على أهميّة تحليل الاستثمارات غير الماديّة، كتلك المُستثمَرة في الموارد البشرية والمُجسَّدة من طرف فِرق الشركات الأمنية الخاصّة وعمليات حفظ السلام أو تدريبات العناصر العسكرية، فهي تحمل ذات الأهمية التّي تمثّلها الاستثمارات في القواعد العسكرية وقواعد الطائرات المُسيَّرة في حساب مدى قوة دولةٍ أجنبيةٍ ما.
- إلى أيّ مدى تُعتبر الاستثمارات الصينية في برامج التدريب المهني فعّالة؟
تُذكّرنا الكاتبة بشيءٍ من أيّام الحرب الباردة لتُوضّح أهمية وفعالية الاستثمار غير المادّي في الشؤون العسكرية والأمنية الذّي تقوم به الصين في إفريقيا وبأنّ للقوة العسكرية وما يرتبط بها من جانبٍ ناعمٍ وجذّاب كالتدريبات وما تمّ ذكره سابقًا مُساهمة فعّالة في تعزيز قوة الصين الصاعدة وتواجدها في إفريقيا، كما تساهم عبر علاقات غوانشي في ربط نخبها العسكرية بالصين. على سبيل المثال، يعتمد الباحث يال ريشموند (Yale Richmond) على دراسة أجراها جنيرال سابق بوكالة المخابرات السوفياتي (KGB) إسمه أوليج كالوجين (Oleg Kalugin)، الذّي قضى عامًا في جامعة كولومبيا الأمريكية في إطار برنامج تبادلٍ طلابي ما بين 1958-1959. أشار كالوجين لأهمية دور مثل هذه البرامج في تقويض الأساس الفكري لنظام الاتحاد السوفايتي. حيث أكّد كالوجين للباحث ريشموند في مقابلةٍ أجراها معه سنة 1997 بأنّ: «التبادلات كانت حصان طروادة في الاتحاد السوفياتي، حيث لعبت دورًا هائلاً في تآكل النظام السوفياتي. لقد فتحت مجتمعًا مغلقًا».
لا شّك بأنّ برامج التبادلات العسكرية تُعتبر آليةً فعّالةً لأنّها تستهدف ضبّاطًا ذوي مراتب رفيعة المستوى والذّين من المرجّح أن يكون لهم قولٌ ما في عملية صناعة القرار في بلدانهم. لذلك فإنّ إحداث تأثيرٍ ما على المسؤولين من شأنه أن يفتح الباب أمام إحداث أثرٍ ما على صناعة السياسات.
إنّ إعلان الصين عن إنشاء أول قاعد بحرية عسكرية لها ما وراء البحار في جيبوتي سنة 2017، ليس أمرًا مفاجئًا وفقًا للكاتبة، كما أنّ تواجدها هناك لا يخلق وجودًا قويًّا للصين في القرن الافريقي، ولكنّه يعكس تأثيرًا لعلاقات دبلوماسيةٍ قويّةٍ تمّ إرساؤها مُسبقًا بين مسؤولين رفيعي المستوى من جيبوتي والصين. تُعتبر هذه القاعدة البحرية واحدةً من الأمثلة العديدة عن التراكم الذّي حدث في العلاقات الثنائية القويّة، ويمكن للمرئ أن يتنبأ برؤية أشياءٍ أخرى كهذه تحدث مستقبلاً في العلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا.
خاتمة واستنتاجات: القوة الارتباطية ما وراء العلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا:
يُمثّل هذا القسم خلاصةً لما توصّل إليه الكتاب من نتائجٍ في كلّ فصل، فهو يعكس الأسئلة البحثية المطروحة في الدراسة ويضع القارئ أمام صورةٍ أشمل للسياسة الخارجية الصينية المنتهَجة في إفريقيا والجنوب العالمي.
يقترح القسم أيضًا ثلاثة مساراتٍ تفتحها نتائج هذا الكتاب، يمكن للبحوث المستقبلية أن تعالجها بشكلٍ أكثر دقّة واتساعًا، وتتمثّل في: 1. توسيع مفهوم القوة في حقل التنظير الخاصّ بالعلاقات الدولية بشكلٍ يشمل التأويلات ما بعد الغربية والفواعل غير الغربية. 2. وضع ممارسات الصين في إفريقيا ضمن سياقٍ أوسع لاستراتيجيات القوى الصاعدة الأخرى في إفريقيا. 3. وضع إفريقيا في سياقٍ أوسع لعملية صناعة السياسة الخارجية الصينية تجاه دول الجنوب العالمي. من شأن هذه المقاربات الثلاث أن تُساعدنا على فهم المزيد عن الصيغة المفاهيمية الصينية للقوة والنظام والهيمنة وكيف تختلف (أو لا تختلف) عن الرؤى الغربية أو عن الشمال العالمي.
إلى جانب هذه الاتجاهات البحثية، يخلص القسم إلى تقديم نقدٍ للنزعة ما بعد البنيوية في حقل التنظير الخاصّ بالعلاقات الدولية، والتّي تفترض بأنّ القوة/السلطة والهيمنة في العلاقات الخارجية هي نتيجة لتمييز وجود “الآخر” المختلف (Othering) حيث تُهيمن “الذات” المتعالية على “الآخر” الأدنى. فمن وجهة نظر تحليل الكاتبة للسياسة الخارجية الصينية في إفريقيا، تبدو القوة/السلطة بأنّها تجري وتشتغل على نحوٍ ناجحٍ ومضبوطٍ نظرًا لعدم وجود تمييزٍ تراتبيٍ للآخر المختلف (Hierarchical othering). تُصوّر الصين نفسها كبلدِ نامي آخر، يقف على قدم المساواة مع الدول الافريقية، وهذا ما يجعل علاقات القوة/السلطة -حسب تحليل الكاتبة- أقلّ مرئيةً وتصادمًا، وبالتالي أكثر نجاحًا.
مع صعود الصين وقوى أخرى عبر الساحة السياسية العالمية، تبرز أنماطٌ جديدةٌ من المواجهات والمقابلات بين الدول، خصوصًا بين الصين ودول الجنوب العالمي. وُجدت هذه المواجهات في السابق دومًا، لكنّها صارت الآن أكثر مرئيةً لباحثي العلاقات الدولية بسبب النفوذ المتنامي للقوى الصاعدة في الهيكل الدولي وآثارها. يُظهر الكتاب بأنّ مواجهات السياسة الخارجية هذه تحظى بملامحٍ متمايزةٍ تتطلّب أُطرًا نظريةً جديدةً لتحليلها، ذلك أنّ الأُطر التّي طُوّرت لدراسة “سياسة القوى العظمى” الغربية وآليات نشر القوة لا تُقدّم مستوى تفسيري كافِ.
إستكشف الكتاب عند بدايته أنماط آليات القوة التّي تبني وتنشر وتعزّز قوة الصين في إفريقيا. جوهر ما أظهرته الكاتبة هو ضرورة النظر في عمليات إنتاج المعرفة وتشكيل رأس المال الاجتماعي ونقل المهارات في السياسة الخارجية الصينية تجاه الدول الافريقية من أجل الفهم الكامل لآليات بناء القوة الصينية. فمن خلال فحص استثمارات الصين في برامج تنمية الموارد البشرية المُقدَّمَة لإفريقيا، تمكّن الكتاب من فحص جانبٍ حيويٍّ لم ينل حظًا وافرًا من التنظير المتعلّق بصناعة سياسة الصين الخارجية.
بعد إعادة تلخيص استنتاجات كلّ فصل وما ورد فيه من منطلقاتٍ فرضية بُرهن عليها بحججٍ وفيرة، تتحدّث لينا بن عبد الله في نهاية الكتاب عن مبادرة الحزام والطريق الصينية كأضخم مشروعٍ استثماريٍ صينيٍ يربط العالم بالصين، اقتصاديًا وتجاريًا (ماديًا)، حيث تُوضّح الكاتبة بأنّ للمشروع جانبًا غير مادّيٍ أيضًا، إذْ تستثمر عبره الصين في رأس المالي البشري في الدول التّي تشملها مشاريع هذه المبادرة. هكذا تؤكّد الكاتبة بأنّ للاطار النظري الذّي يُقدّمه الكتاب قدرة على فحص واستكشاف وإظهار هذا البُعد في سياسة الصين الخارجية واستراتيجيتها الكبرى.
أثناء الحفل الإفتتاحي لمنتدى الحزام والطريق المنعقد في بيجين سنة 2017، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنّ الصين ستمنح: «في السنوات الخمس القادمة 2500 منحةً بحثيةً قصيرةَ المدى لزيارة الصين لفائدة العلماء الشباب الأجانب وتدريب 5 آلاف عالمٍ أجنبيٍ ومهندسٍ ومدير أعمال، وإنشاء خمسين مخبرًا بحثيًا مشتركًا». يُضاف هذا التعهّد لعشرات البرامج الجارية أصلاً لتدريب المعلّمين وتقديم دروسٍ في لغة الماندرين الصينية، وغيرها من منتديات التبادل بين الصين وبلدان آسيا الوسطى على طول خطّ الحزام والطريق. وبالرغم من أنّ مبادرة الحزام والطريق تُعنى أساسًا (في شقّها البرّي) بربط الصين بآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية من خلال بناء مشاريعِ بنيةٍ تحتيةٍ ضخمة وتسهيل دمج الأسواق وتعزيز التجارة، فإنّ عنصرًا كبيرًا من المشروع يُعنى ببرامج نقل المهارات والتّي تمولّها الحكومة الصينية كبرامج تدريب المعلّمين والملتقيات المخصّصة للمسؤولين العموميّين في البلدان المتواجدة على طول خطّ الحزام والطريق، إضافةً إلى برامج تعزيز الدبلوماسية ما بين الشعوب وما بين الأشخاص.
إنّ الاستثمارات الموجّهة لرأس المال البشري في شكل برامج بناء للقدرات وبرامج تدريبية لتعليم لغة الماندرين للمعلّمين المستقبليّين، والندوات التّي تُعقد لأجل الصحفيّين ومنتديات الشؤون الدفاعية وغيرها من ورش العمل الموجّهة للمسؤولين الحكوميّين صارت تُعتبر بمثابة البصمة أو التوقيع الخاصّ لسياسة الصين الخارجية في الجنوب العالمي. تُموَّل هذه البرامج التدريبية من طرف الحكومة الصينية وتُدعَّم من قِبل العديد من المؤسّسات التعليمية في الصين. توضّح الكاتبة بأنّها برامجٌ أحاديةُ الاتجاه والتلقين، حيث يأتي المشاركين من بلدانٍ متنوعة من الجنوب العالمي، بينما يتولّى مهمّة التدريب مدرّبين صينيّين. وحينما تحتاج فِرق الخبراء الصينية إلى الخبرة أو إلى برامج تدريبية فنيّة/تقنية، فإنّها تستعين بارتباطاتها مع البلدان الغربية (ألمانيا، المملكة المتحدة، أستراليا، الولايات المتحدة وغيرها) من أجل تحصيل الخبرة المطلوبة.
إنّ عملية التنشئة الاجتماعية عبر الدبلوماسية الثقافية ليست بالشيئ الجديد على صناعة السياسة الخارجية عمومًا أو على سياسة الصين الخارجية، حيث تُظهِر ممارسات السياسة الخارجية الصينية التّي تعود لحقبة الصين الامبريالية وجود أدلّةٍ على ممارسة الصين للهيمنة عبر الدبلوماسية الثقافية. تُذكِّر الكاتبة في هذا الصدد بنظامٍ قديمٍ اشتهرت به الصين ما قبل حقبة النظام العالمي الويستفالي يشبه “نظام الجزية” يُسمى بـ (Cefeng) أو (Tributary System).3
إشتغل هذا النظام «كمجالٍ اجتماعيٍ لا غنى عنه، وحاولت ضِمنه الصين أن تمارس تنشئةً اجتماعيةً على الآخرين»، وبالتالي كانت الممارسات المُتبّعة للتنشئة الاجتماعية من طرف الصين منقادةً أساسًا بممارسات «الحزم والقسر والاقناع (المُمارس على الآخر) لأجل القبول بممارساتٍ مؤسّساتيةٍ قاعديةٍ تُفضّلها الصين الامبريالية في إدارة علاقاتها مع الآخرين». إنّ الشعور الذاتي للصين بتفوّقها الهويّاتي في النظام ما قبل الويستفالي لم يكن نتيجةً لغزو الصين للأقاليم من أجل فرض نظامها البيروقراطي ومعاييرها على الآخرين. بدلاً من ذلك فإنّ مَأسَسة الممارسات الثقافية -على غرار ممارسات “نظام الترابيتاري” سابق الذكر أو غيره- كانت متطلَّبةً من الأجانب، يُؤدُّونها حينما يطلبون من إمبراطور الصين توفير الحماية لهم أو تسهيل الاتصال التجاري. في سياسة الصين الخارجية المعاصرة، فإنّ أداة الدبلوماسية الثقافية والتبادلات بين الأشخاص وبين الشعوب عنصرٌ حاضرٌ ومركزيٌ في الصين الصاعدة، كما أنّ المقاربة الترابطية والشبكية لمبادرة الحزام والطريق لها صلةٌ بشبكة العلاقات بين الأفراد/الشعوب، مثلما لها صلةٌ بشبكات القوة وربط البنى التحتية.
يفتح الكتاب في نهايته الباب أمام الباحثين لمعالجة قضايا ذات صلة بحاجة إلى توسيع ودراسة علمية مفصلّة. على سبيل المثال، فإنّ نطاق الكتاب لم يركّز على فحص السُبل التّي من خلالها يمارسُ قادة الدول الإفريقية وصنّاع السياسة الخارجية نفوذهم ويفاوضون من خلالها بخصوص تفضيلاتهم مع نظرائهم الصينيّين، وهو خطٌّ بحثيٌ مستقبليٌ آخر قد يُستلهم من هذا الكتاب ويتعلّق بفحص كيفية مناورة الدول الإفريقية في سياق الديناميكية المتغيّرة للنظام الدولي. بالرغم من أنّ هذا الكتاب فحَص في الأغلب سلوك السياسة الخارجية الصينية تجاه الدول الإفريقية، فإنّه أخذ بعين الاعتبار أيضًا مدركات النخب الافريقية والمهنيّين المخرطين في برامج التدريب المهنية ونقل المهارات التّي ترعاها الصين. إحدى أوجه القصور والمحدودية في هذا الكتاب هو افتراضه بأنّ علاقات القوة بين الصين والدول الافريقية هي علاقات غير تماثلية، فلم يفحص الطرق التّي تقوم الفواعل الافريقية (العمومية والخاصّة) عبرها بممارسة القوة/السلطة في علاقاتها مع الصين. نظرًا لديناميكيةٍ أحاديةِ الاتجاه في برامج التدريب المهنية وافتقار النظراء الأفارقة لمعاهدٍ شبيهةٍ بمعهد كونفوشيوس الصيني، افترض هذا الكتاب وجود ديناميكياتٍ تراتبيةٍ للقوة/السلطة في العلاقات القائمة بين الصين وإفريقيا.
ترى الكاتبة وجود درجةٍ مهمّةٍ من التفاوت في القدرات بين الدول الافريقية المختلفة، والذّي يعني تفاوتًا في قدرة الدول الافريقية على تشكيل الحزب الشيوعي الصيني وتحدّيه. لم يراعِ هذا الكتاب وجود مثل هذه التفاوتات نظرًا لاهتمامه بفحص العلاقات متعدّدة الأطراف (لا العلاقات الثنائية) بين الصين والدول الافريقية. لذلك يمكن للبحوث المستقبلية في هذا الموضوع أن تبني على هذه الدراسة من أجل فحص سردية “إفريقيا الصاعدة” على نحوٍ أكثر عمقًا، وإلى أيّ مدى ينطبق هذا الإطار على الوكالة الإفريقية.
علاوةً على ذلك، لم يركّز الكتاب على قياس الآثار المباشرة لبرامج التدريب المهنية المدعومة من الحكومة الصينية والمُقدَّمة للنخب الافريقية، فلم يقم بإجراء تحليلٍ نُظميٍ أو طويل المدى للتأكّد من مسألةِ إلى أيّ مدى تُثمر الاستثمارات في رأس المال البشري المُمولّة من الحزب الشيوعي الصيني في مجالات الحوكَمة والتنمية وقيم الصحافة وحقوق الإنسان وتعود بنتائج إيجابية على الصين مستقبلاً. على سبيل المثال، يمكن للأبحاث المستقبلية أن تركّز على تحديد آثار برامج التدريب المهنيّة لتخبرنا (عبر الوقت) إلى أيّ مدى سيصير لصحفيّين أو لعناصر حزبٍ إفريقي محدّد (تلقّوا تدريبهم في الصين) تفضيلٌ أكبر تجاه الصين وسياسة الصين في بلدانهم المعنيّة.
على العموم، فإنّ اتجاهًا مشتركًا للأبحاث المستقبلية متعلّقة بمثل هذه المجالات يدور حول فحصٍ مقرّبٍ لمكانة إفريقيا ودورها في النظام العالمي، حيث تتساءل هذه الأبحاث عن حدود سعي الدول الافريقية لتنويع اعتماداتها وتحويلها من القوة التقليدية في الشمال والغرب إلى القوى الصاعدة في الشرق والجنوب؟ تندرج مثل هذه الأمثلة ضمن أجندةِ تفكيكِ مركزيةِ نظريات العلاقات الدولية حتّى تصير مشتملة على مقارباتٍ وفواعل وتصوّرات ما بعد غربية لحقل العلاقات الدولية. إنّها تفتح نقاشًا حول الاختلافات القائمة بين سلوك المهنيّين والقوى العظمى في سياق الجنوب العالمي والتّي تختلف بشكلٍ جوهريٍ عن المسارات التقليدية والكولونيالية للقوى الأوروبية. بهذا المعنى فإنّ التنبؤات الواقعية التّي تتنبأ بأنْ تتصرّف كلّ القوى العظمى بطريقةٍ مماثلةٍ ما إن تبلغ عتبةً مُحدّدةً من القدرات المادية، لهي سبيلٌ محدودٌ لتحليل السياسة العالمية اليوم.
أخيرًا، لطالما اعتُبرت العلاقات الدولية وصناعة السياسة الخارجية ذات خاصيّةٍ ارتباطيةٍ أساسًا، وهذا ما يحتّم على علم السياسة أن يُولي أهميةً للرؤية الارتباطية والقوة الانتاجية الارتباطية المُثمرة. يشير ذلك إلى أنّ رابطًا بين صناعة السياسة الخارجية والتنشئة الاجتماعية والقوة الارتباطية ورأس المال الاجتماعي في صناعة السياسة الخارجية قد يبدو واضحًا منذ البداية، ذلك أنّ الأمر الكثير المتعلّق بالدبلوماسية يدور حول العلاقات القائمة بين الدول ونخب الدول والشعوب. هناك آلياتٌ معقدّةٌ تُترجِم العلاقات إلى شبكات غوانشي، بل وحتّى آلياتٌ مقعدّةٌ تضمنُ بأن يَتترجم غوانشي إلى تحقيق أهدافِ سياساتٍ ناجحة. كتاب “تشكيل مستقبل القوة” يتمحور لا حول مدى أهمية الرؤية الارتباطية في صناعة السياسة الخارجية ونظريات العلاقات الدولية فحسب، بل يتعلّق أيضًا بإظهار كيف أنّ رأس المال الاجتماعي وإنتاج المعرفة ونشر القيم تُعتبر آليات جوهرية للارتباط الدولي.
هوامش:
- يُشير مفهوم غوانشي ((Guanxi إلى دلالة التواصل وتجاوز الحواجز القائمة بين الأطراف المتواصِلَة. مجازًا، يوحي بعبور بوابةٍ ما والتواصل والترابط مع من هم في الداخل، فحينما تتجاوز الباب قد تصير “واحدًا منّا” (من أهل البيت)، وحينما تبقى خارجه “فستفصلك الحواجز عنّا”، فهذا المفهوم المستوحَى من الفلسفة الكونفوشيوسية يشير إلى الانفتاح على الاتصال والترابط مع بقيّة الناس والشعوب، ويدعو إلى شبكةِ علاقاتٍ أكثر مرونةً وديناميّة تُرسي لروابط متشابكةٍ تجعل الشعوب المختلفة في المكانة والتموضع في حالة اتصال. كما يشير المفهوم إلى أنّ هذه العلاقات مليئة بحسٍّ عالي من المسؤولية تجاه الآخرين. للمزيد يُنظر لـ:
Emilian Kavalski, Chinese Concepts and Relational International Politics, (All Azimuth Journal, V7, N1, 2018), 87-102.
Or: Qin Yaqing, A Relational Theory of World Politics, (UK, Cambridge.University Press, 2018
2. يرى الباحثين بارنات ودوفال(Barnett and Duvall) وجود جدوى لأربعة أصنافٍ من القوة، وهي: القوة الالزامية-القسريّة، القوة المؤسّساتية، القوة البنيوية، والقوة الإنتاجية.
3. هو نظامٌ صينيٌ قديم يرجع لما قبل نشوء النظام العالمي الويستفالي واستمر قائمًا في الصين إلى ما قبل سقوط سلالة شينغ الصينية سنة 1911. يُعتبر صيغةً لممارسة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الصين، يتضمّن النظام تبادلاتٍ للهدايا بين الحكام الأجانب والإمبراطور الصيني. يستفيد الأجانب من هذا النظام لأنّ الهدايا التّي تعود إليهم من طرف الصينيّين كانت سخيّةً دومًا ومن بين أحسن ما كانت تمنحه الحضارات القديمة المتقدّمة. إضافةً إلى ذلك يقوم الإمبراطور الصيني بتأكيد منصب الحاكم الأجنبي والمصادقة عليه مانحًا إيّاه صيغةً شرعية. في المقابل، يتقبّل الأجانب مكانةً من الطاعة والخضوع للامبراطور، وبالتالي فهم يؤكدّون بذلك تفوّق الحضارة الصينية وشرعية الإمبراطور الصيني. عرف النظام اتساعًا ليشمل نطاقًا واسعًا من العلاقات التجارية التّي حظيَ بها التجار الصينيّون والأجانب على حدٍ سواء وبشكلٍ عظيم. يُنظر:
Chinese Tributary System, (Japan: Walk Japan, 2021)

أستاذة السياسة والشؤون الدولية بجامعة وايك فوريست-الولايات المتحدة، وهي باحثة زائرة بمركز الدراسات الإفريقية في جامعة هارفرد (ربيع-صيف 2023). تُركّز أبحاثها على نظرية العلاقات الدولية، السياسة الخارجية، النظريات النقدية للقوة، سياسة الماضي، إنتاج المعرفة والهيمنة في العلاقات القائمة بين دول الجنوب. تنشر لينا بن عبد الله أبحاثها في مجلّاتٍ محكّمة عالمية، منها دوريّة الدراسات الدولية، فصليّة الدراسات الدولية، فصليّة العالم الثالث، مجلّة العلاقات الدولية والتنمية، فصليّة الدراسات الإفريقية، فصليّة القوى الصاعدة وغيرها. تعمل الباحثة الآن على كتابٍ جديد يهتّم بدراسة النوستالجيا السياسية في السرديات والخطابات الصادرة عن الحكومة الصينية الراهنة بخصوص طريق الحرير الجديد كونه استمرارًا لحقبةِ التبادلات المرتكزة على الصين بمنطقة المحيط الهندي خلال القرن الخامس عشر. يتحرّى المشروع مدى نجاح السياسة الخارجية الصينية في نشر سردياتٍ نوستالجيةٍ عن طريق الحرير والتنظيم المرتكز على الصين الذّي نشأ عنه لأجل ممارسة النفوذ على نخبِ ومواطنيِ البلدان الواقعة على طول طريق الحرير البحري الجديد.

باحث رئيسي بمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA)-جامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بتركيا. تهتّم أعماله البحثية بمجال الجيوبوليتيك، نظريات العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى، جيوبولتيك أوراسيا وبحر الصين الجنوبي وشمال إفريقيا، السياسة الخارجية التركية والسياسة الخارجية الجزائرية. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات والملخصّات الأكاديمية المنشورة بالعربية والإنجليزية بمجلّات مُحكّمة عربية وأجنبية ومراكز أبحاث، منها كتاب: “النظام الدولي الليبرالي: جون ميرشايمر في مواجهة جون آيكينبري-صعودٌ أم سقوط؟” (2021) وكتاب: “أثر التحوّلات الطارئة في بنية النظام الدولي على التوجّهات الكبرى للسياسة الخارجية التركية” (2017) وكتاب: “آفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا” (2015).